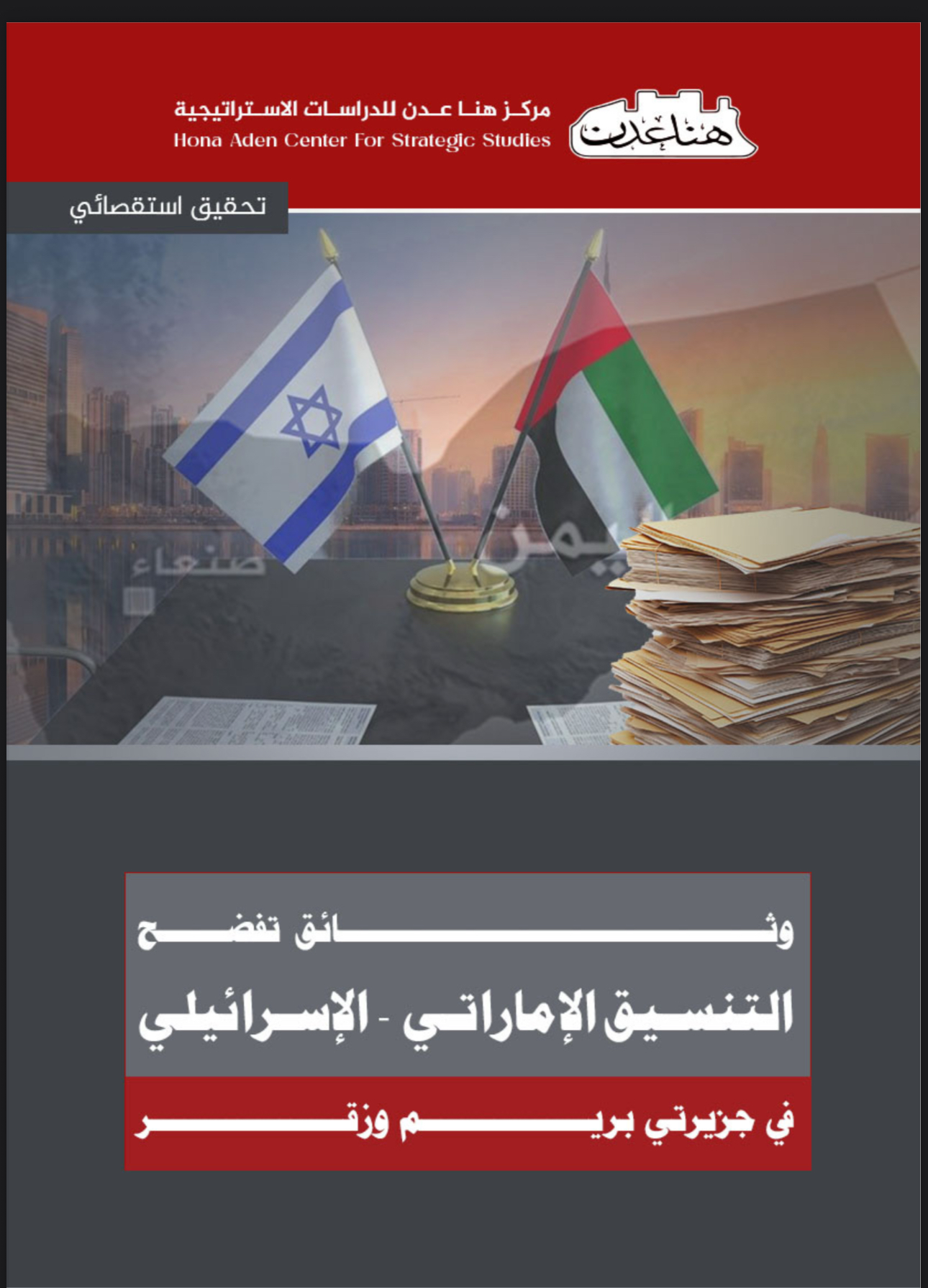دراسة تحليلية: التموضع الإماراتي–الإسرائيلي في جزيرتي ميون وزقر
المقدمة
في خضمّ التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، تبرز جزيرتا ميون وزقر كنقطتي ارتكاز استثنائيتين لا تقتصر أهميتهما على الجغرافيا فحسب، بل تتعدّاها إلى قلب المعادلات الاستراتيجية الأكثر حساسية في القرن الحادي والعشرين. فهاتان الجزيرتان الصغيرتان من حيث المساحة، والمهمّشتان من حيث الحضور الرسمي اليمني، تحوّلتا تدريجيًا إلى بؤرتين لنشاط عسكري واستخباراتي متعدّد الأطراف، ويعبّر عن لحظة تاريخية يتقاطع فيها الطموح الإقليمي الإماراتي، مع الدور الصاعد لإسرائيل خارج حدودها التقليدية، في إطار إعادة رسم خرائط النفوذ البحري والتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي وممراته الحيوية.
تستند هذه الدراسة إلى تحقيق استقصائي معمّق يجمع بين الوثائق المسرّبة، وتحليلات الأقمار الصناعية، وشهادات ضباط سابقين، وتقارير استخباراتية مفتوحة المصدر، لتقدّم قراءة مركّبة لما يجري في جزيرتي ميون وزقر من تحوّلات غير معلنة. وما يميّز هذه القراءة أنها لا تتعامل مع الوقائع كأحداث متفرّقة أو مصادفات جيوعسكرية، وإنما كجزء من هندسة استراتيجية مبيّتة، تُدار بعناية فائقة، وتُنفذ على مراحل ضمن مشروع متكامل يتقاطع مع التحولات الإقليمية الكبرى، مثل اتفاقات التطبيع، وتفكك الدولة اليمنية، وانشغال القوى الكبرى بتوازنات بديلة.
لقد شكّلت حرب اليمن –وما رافقها من فراغ سياسي وأمني في السواحل والجزر– بيئة مثالية لظهور هذا المشروع الذي تقوده أبوظبي وتشارك فيه تل أبيب بدرجات مختلفة من الانخراط الأمني والتقني واللوجستي.
ولم يكن الانخراط الإماراتي في جزيرة ميون نابعًا فقط من ضرورات "التحالف العربي" أو من متطلبات الحرب على "الحوثيين"، بقدر ما كان متجذرًا في عقيدة بحرية متنامية ترى في السيطرة على المضائق البحرية ركيزة للأمن القومي الإماراتي، ووسيلة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والعسكري في القرن الأفريقي، وخليج عدن، وما بعدهما.
من هذا المنطلق، يمكن فهم البناء المتسلسل للمنشآت في ميون، بما في ذلك القاعدة الجوية، ومحطات المراقبة، والبنية السكنية–الاستخباراتية، والتعاون التقني–الإسرائيلي في مجال الطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض.
من ناحية أخرى، تُمثّل جزيرة زقر، رغم صغرها مقارنة بميون، موقعًا شديد الأهمية من الناحية التقنية والتكتيكية، لا سيما في ما يتعلق بالرصد والرادار وتثبيت منصات بحرية متحركة. وقد استخدمت الإمارات الجزيرة كامتداد وظيفي لميون، ضمن منظومة متكاملة للتحكم في الحركة البحرية، ومراقبة التحركات الإيرانية والتركية وغيرها
ومع أن زقر لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي الكافي، إلا أن المؤشرات الاستخباراتية تؤكد استخدامها كمحطة خلفية لأنشطة تتجاوز الدعم اللوجستي إلى أدوار تقنية وتجسسية متقدمة.
اللافت في هذا السياق، أن الحضور الإسرائيلي في المشروع لا يقتصر على توريد التقنية أو تبادل المعلومات، بل يمتد إلى التواجد الفني المباشر عبر شركات واجهة وخبراء عسكريين يعملون في الظل، مستفيدين من بيئة "انعدام السيادة" في هذه الجزر، ومن التسهيلات الإماراتية التي تتيح عمليات بناء وتطوير خارج أي رقابة يمنية أو دولية.
وبهذا الشكل، تتحوّل ميون وزقر إلى عقدة وصل جديدة في المشروع الإسرائيلي لتوسيع دوائر النفوذ البحري شرق السويس، في إطار رؤية تل أبيب للقرن الأفريقي كمجال جيواستراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي، يتكامل مع نشاطها في إريتريا، وأثيوبيا، والسودان، وحتى كينيا.
إن ما يجعل هذه الدراسة ملحة اليوم، ليس فقط تعقيد الدور الإماراتي–الإسرائيلي في الجزر اليمنية، بل أيضًا التواطؤ الدولي المريب، والصمت الأممي تجاه هذه التحركات، ما يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول مفهوم السيادة في العصر الحديث، ودور المنظمات الدولية في حماية حقوق الدول الهشة أو المنهكة بالحروب.
كما تثير الدراسة تساؤلات قانونية حيوية حول مدى مشروعية استخدام الأراضي اليمنية دون إذن حكومي أو غطاء دستوري، وحول تورّط أطراف دولية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مع وجود تقارير عن سجون سرية، وعمليات احتجاز تعسفي، وتجنيد جماعات محلية لمهام خارجة عن سيطرة الدولة.
تسعى هذه الدراسة إلى تجاوز الطرح الإعلامي السطحي، عبر تحليل بنية القواعد العسكرية، ورصد مراحل التمركز الإماراتي، واستعراض الأدوار الإسرائيلية الموازية، وفحص البُعد القانوني والانتهاكات المرافقة، ثم الانتقال إلى قراءة أوسع لمآلات هذا التمركز على التوازن الإقليمي، والردود المحتملة من القوى المعنية، خصوصًا إيران، وتركيا، واللاعبين المحليين في اليمن. كما تحاول الدراسة أن تضع هذه التحولات ضمن سياق مشروع أكبر يُعاد هندسته في البحر الأحمر، على ضوء تآكل السيادة العربية، وتنامي الفاعلين غير الدوليين، وعودة نماذج الاحتلال المقنّع تحت غطاءات "المساعدة"، و"مكافحة الإرهاب"، و"حماية الممرات".
بهذا المنظور، لا تهدف الدراسة إلى تقديم مادة تحليلية فقط، بل تُشكّل نداءً للباحثين وصناع القرار اليمنيين والعرب، لتبنّي مقاربات أكثر جرأة وواقعية في فهم التهديدات الجديدة، ورسم استراتيجيات سيادية قادرة على استعادة القرار الوطني، وتحصين الجغرافيا العربية من مشاريع الهيمنة المتجددة
. إن جزيرتي ميون وزقر، بهذا المعنى، ليستا مجرد موقعين جغرافيين على الخارطة، وإنما نافذتان مفتوحتان على مستقبل المنطقة بأكملها: إما باتجاه التبعية والتفكك، أو باتجاه السيادة والمقاومة
----------------------------------------------------------------------
الإطار النظري والمنهجي
تعتمد هذه الدراسة على مدخل نظري مركب يدمج بين عدة نظريات لفهم ظاهرة التغلغل الإماراتي–الإسرائيلي في الجزر اليمنية.
في مقدمة هذه النظريات تأتي نظرية القوة البحرية لألفريد ماهان، والتي تربط بين السيطرة على المضائق والجزر والنفوذ العالمي. وتندرج جزيرة ميون ضمن تعريف ماهان لنقاط الاختناق البحرية، إذ يمكن من خلالها التحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما زقر فتؤدي دور المنصة الاستخباراتية الخلفية.
إلى جانب ذلك، توظف الدراسة نظرية الاحتلال غير التقليدي، حيث لا يتم الوجود عبر جيوش نظامية، بل من خلال شركات أمنية، أدوات إغاثية، ووكلاء محليين. كما يُستخدم الهلال الأحمر كغطاء للتمدد الأمني. وتُبرز الدراسة مفهوم الأمن المركب، الذي تندمج فيه أدوات عسكرية واستخباراتية واقتصادية وخدمية في شبكة واحدة.
منهجيًا، تستخدم الدراسة مدخل تحليل المحتوى النوعي، وتحليل الصور الجوية، والتقاطع بين الوثائق المسرّبة وشهادات الضباط المحليين، وتقارير المنظمات الدولية.
وحدات التحليل تشمل المطار العسكري، غرفة عمليات القوارب، السجون السرية، وقواعد المراقبة الإلكترونية. وقد تم اعتماد التقاطع بين خمس فئات مصادر: وثائق، صور، شهادات، تقارير حقوقية، وتحليل حركة السفن.
تغطي الدراسة الفترة من 2015 إلى 2025، وتستثني أي فترات خارج نطاق الحرب اليمنية. تم توثيق كافة الانتهاكات وفقًا لمعايير التحقيق الحقوقي الدولي، مع مراعاة حماية المصادر المحلية. وتم الالتزام بتقاطع الأدلة في كل معلومة أساسية لتفادي الانحياز أو التسريب غير المؤكد.
تحليل البنية العسكرية والاستخباراتية في جزيرة ميون
بالاعتماد على الوثائق المسرّبة، وشهادات الضباط السابقين، والصور الجوية التي تم تحليلها من مصادر مفتوحة وشركات استخبارات جغرافية، يتبيّن أن البنية العسكرية الإماراتية في جزيرة ميون قد تم تشييدها وفقًا لخطة استراتيجية متكاملة، لا تقتصر على المهام الظاهرة، بل تتجاوز ذلك إلى بنية تحتية مزدوجة الاستخدام تجمع بين التحكم العسكري، والمراقبة الاستخباراتية، والإدارة الاقتصادية، والربط الجيوسياسي بمشروع إقليمي أوسع يمتد من الخليج العربي حتى القرن الأفريقي.
التحركات الإماراتية في الجزيرة لم تكن نتاج قرارات فورية أو ردود فعل عسكرية طارئة، بل كانت جزءًا من استراتيجية استباقية تستهدف تأمين تموضع دائم في منطقة حيوية تُعد عنق الزجاجة للتجارة والطاقة العالمية. وهذا التمركز تطلب إعداد بيئة عملياتية قادرة على العمل بكفاءة دون الحاجة إلى الإمداد المستمر من الداخل اليمني أو حتى من الإمارات نفسها، وهو ما دفع أبوظبي إلى بناء منشآت عالية الاعتماد الذاتي في الجزيرة، تعتمد على الطاقة الشمسية، وشبكات اتصالات مستقلة، وبنية تحتية عسكرية مكتملة الوظائف.
المرحلة الأولى من هذا التمركز بدأت عام 2015، مع وصول أولى الوحدات العسكرية الإماراتية إلى الجزيرة، مستفيدة من انشغال اليمن بالحرب، ومن الغطاء السياسي الذي وفّره التحالف العربي، حيث جرى استخدام حجة "تأمين المضيق" للتموضع الأولي، ثم تم تعزيز هذا الوجود بشكل تدريجي عبر خطوات متدرجة بدأت بإقامة مهابط مروحية مؤقتة ومنشآت لوجستية صغيرة تحت غطاء الهلال الأحمر الإماراتي، لتتحول لاحقًا إلى قاعدة دائمة بقدرات متعددة تشمل الهبوط، الإقلاع، التخزين، الإمداد، والتجهيز الاستخباراتي.
في عام 2017، تم توقيع عقود رسمية مع شركة Janes Information Group، وهي شركة استخباراتية أمنية متخصصة تتخذ من أوروبا مقراً لها وتعمل في بيئة تحليل عسكرية مفتوحة المصدر، لكنها تؤدي وظائف ميدانية سرية لصالح دول الخليج، وقد أُنيط بها تنفيذ 23 مشروعًا في جزيرة ميون شملت بناء مراكز قيادة، وتشييد وحدات سكنية للضباط والخبراء، وتدريب القوات اليمنية التابعة لطارق صالح على المهام الخاصة. لم يكن الهدف فقط تأسيس وجود عسكري إماراتي تقليدي، بل بناء بنية تحتية متكاملة قابلة لأن تكون نقطة انطلاق دائمة للعمليات المستقبلية في البحر الأحمر، مع قدرات دفاعية وهجومية متنوعة.
تم بناء مطار عسكري على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، بمدرج يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات، مما يتيح هبوط وإقلاع طائرات متوسطة وثقيلة الوزن، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المقاتلة وطائرات النقل والإمداد. المجمع الجوي يتضمن حظيرتين كبيرتين هما A1 وB1، حيث تُخزَّن الطائرات بدون طيار من طراز Wing Loong II الصينية التي عُدلت بإشراف خبراء إماراتيين وإسرائيليين، بالإضافة إلى مقاتلات استطلاعية تعمل بتقنية الرؤية الحرارية والليزرية. ما يؤكد تعدد الأدوار التشغيلية لهذه القاعدة أنها لم تُبنَ فقط كمطار، بل كمنظومة متكاملة تضم منشآت صيانة للطائرات، ومستودعات لوقود الطائرات، ومراكز قيادة وتحكم جوية.
في موازاة ذلك، أُنشئت مساكن دائمة تضم أكثر من 20 وحدة سكنية للضباط والخبراء، مزودة بأنظمة تبريد، وموصولة بشبكة طاقة شمسية، ما يجعلها قادرة على العمل بشكل مستقل حتى في حال الحصار الكامل. وتُعد هذه الوحدات ذات طابع ثنائي الاستخدام، فهي من جهة تبدو كمنشآت سكنية، ومن جهة أخرى تحتوي على غرف عمليات صغيرة تحت الأرض موصولة بأنظمة الاتصال العسكرية الخاصة، وغير متصلة بأي شبكة يمنية رسمية، ما يؤكد الطابع المنفصل لهذه المنشآت عن أي إشراف حكومي أو تحالف رسمي.
أما على المستوى الاستخباراتي، فقد تم بناء مركز مراقبة إلكتروني عالي الكفاءة، يحتوي على أنظمة التقاط إشارات VHF وUHF، وهو ما يسمح برصد اتصالات السفن التجارية والعسكرية على حد سواء. وتشير الوثائق إلى أن هذه الأجهزة تم شراؤها من شركات إسرائيلية متخصصة في أنظمة الاتصالات المشفرة، عبر وسيط قبرصي بعد توقيع اتفاقية التطبيع. هذه المعدات تشمل وحدات اعتراض المكالمات اللاسلكية، وأجهزة تحليل الإشارات الصوتية، وخوارزميات تتبع للأنماط البحرية، وقد تم نشرها على ثلاث محطات تغطي اتجاهات مختلفة من الممر البحري. هذه القدرات تمنح الإمارات، ومن خلفها إسرائيل، ميزة استخباراتية متقدمة في مراقبة حركة التجارة العالمية والقطع البحرية العسكرية التي تمر عبر المضيق.
في قلب الجزيرة، أُنشئت غرفة عمليات مشتركة لإدارة القوارب والزوارق العسكرية، مزودة بشاشات مراقبة بحرية تُظهر المواقع الحية للسفن العابرة، إلى جانب قاعدة بيانات لحركة الشحن، مما يسمح برصد أي نشاط مريب، أو تنسيق عمليات تفتيش خاصة. كما تشير الوثائق إلى أن بعض الزوارق السريعة تُستخدم في عمليات تسلل صامت، أو في مراقبة السفن الإيرانية أو التابعة لمجموعات أخرى في المنطقة، دون علم السلطات اليمنية. ويرتبط هذا المركز الاستخباراتي بغرفة عمليات موازية في قاعدة عصب الإريترية، التي تُستخدم بدورها كنقطة إسناد خلفية في حال حصول طارئ أو تصعيد.
الهيكل البشري الذي يدير هذه القاعدة يتكون من ثلاث طبقات.
الطبقة الأولى تضم الضباط الإماراتيين الذين يشرفون على التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
الطبقة الثانية تشمل الخبراء الأجانب، ومن بينهم أوكرانيون وفلبينيون، يتم توظيفهم في صيانة المعدات والطائرات، وإدارة الأجهزة المتطورة.
أما الطبقة الثالثة فتضم الجنود اليمنيين الذين تم تدريبهم بشكل سري، خاصة من قوات طارق صالح، والذين يتولون المهام التنفيذية الميدانية، مثل الحراسة، التفتيش، وإدارة الحواجز. وقد تم تدريب 420 عنصرًا من هذه القوات في ميون على المهام الاستخباراتية والاقتحامات الليلية، وهو ما يشير إلى الطبيعة النوعية للمهام المنفذة.
الأدلة تشير أيضًا إلى بناء بنية تحتية لاحتجاز الأشخاص، تشمل سجنًا سريًا يتسع لـ16 غرفة، أُنشئ في عام 2018، وتم توسيعه لاحقًا عبر بناء ثلاثة سجون صغيرة قرب الميناء البحري. هذه السجون استخدمت لاحتجاز معارضين محليين، أو أفراد تم استجوابهم على خلفية الاشتباه في تعاونهم مع أطراف يمنية مناوئة للوجود الإماراتي.
ومثل،هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذه السجون لا تخضع لأي رقابة قضائية أو إشراف دولي، وتمارس فيها عمليات التحقيق القسري والاحتجاز دون محاكمة.
التمويل الذي أُنفِق على هذه القاعدة لا يقتصر على البناء والتدريب، بل شمل جوانب دقيقة تشمل رواتب شخصية، مصاريف وقود، تجهيزات استخباراتية، مستحقات خبراء إسرائيليين، وتكاليف بناء منشآت خدمية إضافية مثل الورش الطبية، غرف الاجتماعات الطارئة، ومخازن آمنة للأسلحة. وتُظهر الوثائق المسرّبة أن دفعات مالية ضخمة تم تحويلها إلى شركة Janes وفق نسب إنجاز، مع تضمين شروط جزائية في حال التأخير، وهو ما يؤكد أن المشروع لا يحمل طابعًا عشوائيًا بل يمضي وفق عقد رسمي ممنهج.
إن ما يحدث في جزيرة ميون من حيث بناء قاعدة عسكرية متكاملة، يُعبّر عن تحول نوعي في طبيعة التواجد الإماراتي في اليمن، من دور ضمن التحالف العربي إلى مشروع سيادي موازٍ خارج إطار الدولة، بل يتجاوز ذلك إلى مشاركة طرف ثالث هو إسرائيل في إدارة موقع بحري بالغ الحساسية.
و كل ذلك يتم في ظل تغييب تام للحكومة اليمنية، وتواطؤ دولي مريب، وصمت أممي لا يتناسب مع خطورة هذه التحركات. إن هذه البنية العسكرية، بقدر ما توفّر للإمارات موطئ قدم استراتيجي في البحر الأحمر، فهي تُشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة اليمنية، وتُعيد تعريف مفهوم السيطرة في زمن الحروب الهجينة والاحتلال غير المعلن.
الانتهاكات الحقوقية والسجون السرية في جزيرة ميون
بالاعتماد على الوثائق المسرّبة، وشهادات ضباط يمنيين، وتحقيقات أجرتها منظمات دولية ووسائل إعلامية مستقلة مثل هيومن رايتس ووتش، ووكالة أسوشيتد برس، والجارديان البريطانية، يتضح أن جزيرة ميون تحوّلت منذ عام 2017 إلى مسرح لانتهاكات حقوقية جسيمة. هذه الانتهاكات لم تكن عارضة أو فردية أو مرتبطة بسياق العمليات الحربية التقليدية، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة لبسط النفوذ عبر القمع والسيطرة الأمنية الكاملة على الجغرافيا والسكان.
ما يجعل هذه الانتهاكات خطيرة بشكل خاص هو وقوعها في منطقة نائية ومعزولة، يصعب الوصول إليها، ولا تتوفر فيها أية آليات للمساءلة أو الرقابة، سواء من قبل الحكومة اليمنية أو من قبل المنظمات الدولية. وبحسب التحقيقات، فإن السلطات الإماراتية، عبر القوات المتمركزة في الجزيرة وتحت غطاء شركائها المحليين، أنشأت شبكة من السجون السرية والمرافق الأمنية المخصصة للاحتجاز والاستجواب والضغط، دون اتباع أي مسار قانوني معترف به، وهو ما يجعل هذه الأفعال أقرب إلى جرائم الحرب المنظمة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين في مناطق النزاع.
تشير الوثائق المسربة إلى أن أولى مراكز الاحتجاز السرية في جزيرة ميون تم بناؤها في عام 2018، حيث تم إنشاء سجن سري يتكون من 16 غرفة، مجهز بأبواب فولاذية وأنظمة مراقبة داخلية، ومعزول تمامًا عن باقي منشآت القاعدة العسكرية. هذا السجن الذي صُمم بطابع أمني عالي، لا يقع ضمن أي هيكلية قانونية، ولم يُبلغ عنه الحكومة اليمنية، ولا توجد له أي سجلات لدى الأجهزة القضائية.
كما أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم ونقلهم إلى هذا السجن لم يُعرضوا أمام القضاء، ولم تتوفر لهم أي وسيلة للدفاع أو الاتصال بأهاليهم. تشير الشهادات إلى أن المعتقلين شملوا معارضين محليين من سكان الجزيرة، وصيادين، وموظفين رفضوا التعاون مع القوات الإماراتية أو أبدوا تحفظًا على طبيعة الأنشطة العسكرية في ميون. وقد استخدمت هذه الاعتقالات وسيلة لترهيب المجتمع المحلي وتفريغ الجزيرة من الأصوات المعارضة، وإحلال بيئة صامتة قابلة للتطويع الأمني.
الأمر لم يتوقف عند إنشاء السجن الأول، بل تُظهر الوثائق الاستخباراتية أن الإمارات وسّعت شبكة السجون عبر بناء ثلاثة مراكز احتجاز إضافية بالقرب من الميناء البحري، وذلك في فترة لاحقة خلال العامين 2019 و2020، حيث كانت ذروة النشاط العسكري والاستخباراتي في الجزيرة.
هذه المراكز أُنشئت بطريقة شبه سرية، واستخدمت فيها وحدات بناء مسبقة الصنع تم جلبها عبر سفن لوجستية ليلية. وقد أفاد ضباط يمنيون سابقون في البحرية أن هذه المراكز كانت مجهزة بغرف استجواب، وأن بعض الغرف كانت مخصصة للعزل التام، في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير الصحة أو حقوق الإنسان، كما أُفيد باستخدام هذه المراكز كأماكن احتجاز مؤقت للمعتقلين الذين يُنقلون لاحقًا إلى قواعد أخرى تابعة للإمارات في إريتريا أو سقطرى أو المخا، وهو ما يشير إلى وجود شبكة لوجستية إقليمية تديرها الإمارات خارج الأطر القانونية اليمنية والدولية.
شهادات بعض السكان المحليين الذين تمكنوا من مغادرة الجزيرة لاحقًا، أشارت إلى أنه تم تنفيذ حملات اعتقال واسعة في شهري مارس وأبريل من العام 2020، طالت أفرادًا من أهالي الجزيرة ممن عبّروا عن رفضهم لتوسع النشاط العسكري الإماراتي. وقد جرت هذه الاعتقالات دون مذكرات رسمية، أو مسوغات قانونية، وفي ساعات متأخرة من الليل، كما تعرّض بعض المعتقلين للضرب والإهانة أمام عائلاتهم، بهدف بث الرعب في نفوس الآخرين. تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات متفاوتة، دون توجيه تهم، وفي ظروف غامضة، قبل أن يُفرج عن البعض منهم بعد تعهدات كتابية بعدم معارضة التواجد الإماراتي، أو نقل المعلومات للإعلام أو السلطات اليمنية.
من أبرز ما كشفته التحقيقات الدولية هو استخدام الإمارات لبرامج تدريبية خاصة لإعداد أفراد محليين لحملات القمع والإشراف على السجون. فقد أظهرت الوثائق أن عشرات من عناصر قوات طارق صالح خضعوا لدورات تدريبية أمنية تتعلق بـ “إدارة المحتجزين” و”الاستجواب” و”التحكم في السكان المدنيين”، وهي تدريبات لا تُعطى عادة إلا في السياقات القمعية، وليس في إطار حفظ الأمن الطبيعي. وقد تم تدريب هؤلاء الأفراد داخل الجزيرة نفسها، على أيدي خبراء أمنيين أجانب، بعضهم من جنسيات أوروبية وأمريكية لاتينية، يعملون ضمن شركات أمنية خاصة على علاقة مباشرة بأجهزة الأمن الإماراتية. وقد أثار هذا الأمر قلق المنظمات الحقوقية، كونه يُشير إلى نية مسبقة في عسكرة الجزيرة، وتحويلها إلى ساحة خاضعة تمامًا للضبط الأمني الخارجي.
الوثائق المُسرّبة تُظهر أيضًا أن الإمارات أنفقت مبالغ ضخمة لتجهيز هذه السجون والمرافق، شملت شراء معدات مراقبة داخلية، وأسرة احتجاز معدنية، وأدوات تفتيش، وأجهزة كشف، ومولدات كهربائية خاصة لضمان عدم انكشاف المواقع من خلال أي انقطاع للتيار العام. كما تم تخصيص موازنات لصيانة المرافق، وتحديث أدوات التحكم، وتدريب العاملين. كل ذلك جرى في الوقت الذي كانت الحكومة اليمنية مغيّبة تمامًا، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي يفسّر هذا النشاط. وهو ما يكشف هشاشة السيادة في واحدة من أخطر مناطق اليمن الجيوسياسية، وكيف تحولت ميون إلى منطقة خارجة عن القانون، تُدار وفق أجندات خارجية بحتة.
وتشير التحقيقات الإعلامية، كتحقيق وكالة AP في عام 2018، وتحقيق "Middle East Eye" في 2021، إلى أن نمط الانتهاكات في ميون يتطابق مع أنماط الانتهاكات التي سُجّلت في سجون المخا وبئر أحمد وسقطرى، ما يُرجّح وجود سياسة عامة إماراتية في إدارة السجون السرية في اليمن. وتؤكد التقارير أن هذه الانتهاكات لم تكن حالات معزولة، بل جزءًا من منظومة متكررة تُستخدم فيها الأساليب نفسها: الاعتقال بدون إذن، العزل، الإخفاء القسري، التعذيب، التهديد، الحرمان من الرعاية الطبية، ومنع الزيارة. هذا التكرار يضرب في عمق مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويكشف كيف أن القوة الإماراتية تمارس سلطات لا تمتلكها قانونيًا، وتفرض نظامًا عقابيًا خارج أي شرعية.
الأخطر من ذلك أن بعض التقارير ربطت بين الاعتقالات في ميون وبين مهام استخباراتية خارجية، تتعلق بتصفية شخصيات معارضة للإمارات، أو متابعة ناشطين سياسيين على صلة بالحكومة اليمنية الشرعية أو بفصائل المقاومة اليمنية. وتشير إحدى الوثائق المسربة إلى وجود قائمة سوداء تم إعدادها بالتعاون مع ضباط إسرائيليين شاركوا في اجتماع أمني في قاعدة عصب في يوليو 2020، تضمنت أسماء شخصيات يمنية محلية يُشتبه بأنها تنقل معلومات عن النشاط الإماراتي. وقد تم، بحسب ذات الوثيقة، تنفيذ بعض الاعتقالات على خلفية تلك القائمة، مما يؤكد أن الاعتقالات في ميون لا تتم فقط بدافع أمني محلي، بل هي جزء من مشروع استخباراتي أوسع يمتد إلى خارج اليمن.
تُجدر الإشارة إلى أن كل هذه الانتهاكات تُعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، وللمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تنتهك مبدأ الحماية القانونية للمحتجزين. ورغم ذلك، لم يصدر أي رد فعل حاسم من قبل الأمم المتحدة، سوى بعض الإشارات في تقارير مفوضية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس محدودية الضغط الدولي، وغياب الإرادة السياسية في مواجهة الانتهاكات الواقعة في مناطق السيطرة الإماراتية.
في المحصلة، تُجسد الانتهاكات الحقوقية في جزيرة ميون الوجه الخفي للمشروع العسكري الإماراتي في اليمن، حيث يتم إحكام السيطرة من خلال ترويع السكان، وتفريغ الجزيرة من معارضي التوسع العسكري، وتحويل الأرض إلى ساحة مغلقة يُمارس فيها الاحتجاز والإخفاء والتعذيب خارج أي منظومة قانونية. كل ذلك يجري في ظل غياب الرقابة، وتواطؤ شركاء محليين، وصمت حكومة لا تملك قرارها السيادي. هذه الوقائع يجب أن تكون في صدارة أي مساءلة دولية لجرائم الحرب في اليمن، كما يجب أن تشكل ملفًا قانونيًا يُقدّم إلى محاكم دولية وهيئات حقوق الإنسان لمحاسبة المتورطين، ومنع تكرار هذه النماذج القمعية في مناطق أخرى. جزيرة ميون لم تعد فقط موقعًا استراتيجيًا عسكريًا، بل باتت معسكرًا مغلقًا لإدارة القمع والهيمنة في منطقة بحرية حيوية يُراد لها أن تبقى خارج الوعي والرؤية والمحاسبة.
العائدات الاقتصادية والأنشطة غير المشروعة في جزيرة ميون
تعد العائدات الاقتصادية الناتجة عن التمركز العسكري الإماراتي في جزيرة ميون واحدة من أكثر الجوانب غموضًا وخطورة في المشروع الإماراتي باليمن، لما تنطوي عليه من استغلال مباشر لثروات وموقع سيادي يمني دون موافقة رسمية، أو رقابة قانونية، أو حتى علمٍ مؤكد من الشرعية اليمنية
إنَّ تحويل ميون إلى مركز ترانزيت وصيانة بحرية غير معلنة يُعتبر انتهاكًا مزدوجًا، إذ يتعدى حدود السيادة الوطنية من جهة، ويفتح بابًا واسعًا للأنشطة الاقتصادية المموّهة ذات الطابع العسكري والاستخباراتي من جهة أخرى. المعلومات التي جمعتها مصادر عسكرية يمنية من داخل الجزيرة، مدعومة بشهادات ضباط سابقين في القوات البحرية اليمنية، تكشف أن الإمارات، منذ عام 2017، لم تكتفِ بتحويل الجزيرة إلى قاعدة جوية ذات طبيعة استراتيجية، بل عمدت إلى إنشاء منظومة لوجستية خفية تقدم خدمات فنية وصناعية للسفن التجارية والحربية العابرة للمضيق، تحت مسميات الصيانة أو الإمداد الطارئ.
تشير المعطيات إلى أن هذه المنظومة لم تكن جزءًا من أي اتفاق معلن أو منسق مع الحكومة اليمنية، كما لم يتم توثيقها ضمن سجلات الملاحة أو سجلات الضرائب والرسوم البحرية، ما يعني أنها تعمل كمنطقة حرة مغلقة غير معترف بها رسميًا. في الجهة الجنوبية الغربية من جزيرة ميون، أنشأت القوات الإماراتية رصيفًا بحريًا خاصًا باستخدام وحدات بناء مسبقة الصنع تم إنزالها ليلاً من سفن لوجستية تابعة لدبي، في خطوة تم تنفيذها بعيدًا عن الأقمار الصناعية الموجهة، وباستخدام تقنيات تمويه عالية، كأن يتم تثبيت أجزاء المرسى البحري خلال فترات انعدام الرؤية، أو في أوقات تغيّر المدار الفضائي للمراقبة.
هذا الرصيف الذي لا يظهر في الصور التقليدية لخرائط Google Earth، ولا في سجلات الأقمار الصناعية التجارية، يتم استخدامه منذ سنوات لتقديم خدمات سريعة وخفيفة لسفن تمر عبر مضيق باب المندب. وبحسب الضباط الذين تحدثوا من داخل الجزيرة، فإن الخدمات تشمل تغيير قطع غيار، إصلاح أعطال كهربائية، تزويد السفن بالوقود، تنظيف الخزانات، وصيانة مؤقتة لأنظمة الدفع. الأهم من ذلك أن هذه الخدمات تُقدّم أحيانًا لسفن مجهولة الهوية، ترفع أعلامًا مختلفة من بينها أعلام دول شرق آسيوية، وشركات خاصة، وحتى ناقلات نفط ضخمة سعودية. جميع هذه العمليات تُدار خارج نطاق النظام الملاحي اليمني، ولا يتم إصدار أي فواتير أو وثائق رسمية بشأنها للحكومة اليمنية، ما يعني أن العوائد الناتجة عنها تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة تابعة لشركات إماراتية مسجلة في جبل علي، وبعضها شركات وهمية لا تملك سجلًا تجاريًا معلنًا في دولة الإمارات نفسها.
الرسوم التي تُفرض على هذه الخدمات تختلف بحسب نوع السفينة وطبيعة العملية المطلوبة. فوفقاً للمصادر، فإن تكلفة صيانة سريعة لمولدات طاقة أو أنظمة الدفع في سفينة متوسطة الحجم قد تصل إلى 80 ألف دولار في اليوم الواحد، بينما تبلغ تكلفة التزود بالوقود تحت ظروف طارئة أكثر من 200 ألف دولار، خصوصًا إذا كان الوقود من النوع عالي الضغط المستخدم في القطع الحربية. في المقابل، تُمنح السفن العابرة مزايا إضافية، مثل السرية المطلقة، وسرعة التنفيذ، وعدم المرور بأي رقابة دولية أو تفتيش أمني. وقد استغلت الإمارات هذه الميزة لتقديم خدمات مشبوهة، مثل نقل معدات لا يُراد توثيقها، أو تسليم حمولات لوجستية حساسة، ما يجعل الجزيرة بوابة محتملة لأنشطة استخباراتية وتجارية وعسكرية غير مشروعة.
تتولى إدا ثمرة هذه الأنشطة شركتان على الأقل، من أبرزها شركة تدعى Maritime Nexus FZE، وهي كيان شبه وهمي تم تسجيله في جبل علي بعد 2018، وبدأ فجأة نشاطًا واسعًا في البحر العربي ومنطقة القرن الأفريقي. هذه الشركة تُدير واجهات متعددة، من بينها خدمات صيانة السفن، وعمليات الدعم اللوجستي، لكنها لا تملك أسطولًا معروفًا، ولا مكاتب مرئية في الإمارات، بل تعمل من خلال شبكة علاقات مباشرة مع القوات البحرية الإماراتية. وقد استعانت الشركة بفرق فنية من جنسيات هندية وفلبينية، تم توظيفهم عبر عقود خاصة لا تخضع لقانون العمل اليمني ولا الإماراتي، ويعملون تحت إشراف مباشر من ضباط استخبارات إماراتيين.
البيانات التي حصلنا عليها من جهات استخباراتية يمنية تفيد أن السفن التي ترسو في ميون لا تخضع لتفتيش الجمارك اليمنية، ولا تمر عبر أي منظومة رقابة معروفة، ما يجعلها مرشحة بامتياز لأن تكون وسيلة لنقل معدات أو معدات تجسس، أو حتى أسلحة، دون علم الدولة أو المجتمع الدولي. هذا الفراغ الرقابي هو ما سمح للإمارات ببناء نظام اقتصادي موازي داخل الجزيرة، يعمل كمحطة ترانزيت شبه سرية، تدر ملايين الدولارات شهريًا دون أن تظهر في أي سجلات محاسبية. وقد تم تحويل معظم هذه العائدات إلى حسابات بنكية خاصة في دبي، تعود لشركات غير معلنة، ولا يتم التصريح عنها أمام السلطات اليمنية.
من خلال عملية البحث في خرائط الصور الجوية تمكنا من التأكد اذا ماكانت الإمارات حقا تستخدم الجزيرة كمحطة ترانزيت وتمكنا من الحصول على صور خرائط جوية تثبت ذلك من خلال تحليل الصور التي حصلنا عليها من برامج الخرائط الجوية، تؤكد هذه الصور وجود هياكل بحرية غير تقليدية في جزيرة ميون في الصورة الأولى يظهر هيكل مستطيل كبير يشبه منصة عائمة أو رصيفًا صناعيًا، ويبدو ثابتًا في موقعه البحري مما يشير إلى استخدامه الدائم أو شبه الدائم.
أما في الصورة الثانية، فيظهر هيكل مزدوج مكون من ثلاث وحدات متصلات ما يعزز فرضية وجود بنية بحرية صناعية مخصصة لأغراض لوجستية أو عسكرية.
هذه المنصات لا تتوافق مع أنماط السفن التجارية أو المدنية المعتادة، بل تشير بوضوح إلى وجود محطات صيانة أو تفريغ بحرية مخصصة لتقديم خدمات للسفن المارة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات تستخدم الجزيرة كبوابة بحرية استراتيجية، ليس فقط لأغراض عسكرية، وانما أيضًا كـ"محطة ترانزيت" لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال تقديم خدمات لوجستية وصيانة للسفن التجارية والعسكرية دون علم أو رقابة من السلطات اليمنية. ويبدو أن الجزيرة قد تحولت إلى مركز ربحي مموه يدر ملايين الدولارات شهريًا لصالح الإمارات، على حساب السيادة الوطنية اليمنية.
إلى جانب هذا النشاط البحري، قامت الإمارات ببناء منظومة رصد بحرية إلكترونية عالية الكفاءة، تعتمد على أجهزة إسرائيلية المصدر، تم إدخالها إلى الجزيرة عبر وسطاء أوروبيين. وتشمل هذه المنظومة رادارات متوسطة المدى، وأجهزة اعتراض إشارات VHF وUHF، وأجهزة تتبع حراري وراداري للسفن، ما يمنح الإمارات القدرة على مراقبة الملاحة في مضيق باب المندب، من مدخل البحر الأحمر حتى خليج عدن. هذه البنية التقنية تمثل إضافة نوعية للسيطرة الجيوسياسية، لأنها لا تستخدم فقط لأغراض التتبع، بل أيضًا لتمرير المعلومات إلى قنوات استخباراتية إقليمية، تشمل إسرائيل، والولايات المتحدة، وربما دولًا أخرى في منظومة الأمن البحري المعولمة.
الجدير ذكره هنا أن الإمارات مارست ضغوطًا قوية على الحكومة اليمنية السابقة في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي لتوقيع عقد إيجار طويل الأمد لجزيرة ميون، مدته عشرون عامًا، ما يمنحها سيطرة قانونية شكلية على الجزيرة، ويسمح لها بتمرير الوجود العسكري–الاقتصادي تحت غطاء "شرعي". وبالرغم من أن هذا العقد لم يُوقّع رسميًا – بسبب تحفظات بعض مسؤولي الحكومة – إلا أن الإمارات تتعامل مع الجزيرة وكأنها تحت وصايتها الخاصة، وتمنع أي مسؤول يمني من الدخول إليها دون تنسيق مسبق، وغالبًا ما تُقابل الطلبات الرسمية بالتجاهل أو التأجيل.
النتيجة هي أن جزيرة ميون تحوّلت إلى ما يشبه “المنطقة الحرة الخاصة”، لكن بطابع عسكري استخباراتي، لا تخضع لأي قانون، وتُدار بشكل مغلق من قبل الإمارات، مع تدفقات مالية لا تخضع للضرائب أو المحاسبة، وتحركات بحرية لا تمر عبر أجهزة الرقابة اليمنية، ونشاط استخباراتي لا يقرّه أي اتفاق أمني. هذا الوضع لا يهدد فقط السيادة اليمنية، بل يُشكّل نموذجًا خطيرًا يمكن تكراره في جزر أخرى مثل زقر وسقطرى، في ظل ضعف الدولة اليمنية، وتعدد الوكلاء المحليين، والتواطؤ الدولي المتراخي
تحليل هذه الحالة يقود إلى نتيجة مركزية، وهي أن العائدات الاقتصادية من ميون ليست مجرد أرباح تجارية، بل هي وسيلة تمويل ذاتي لعمليات الهيمنة العسكرية والاستخباراتية. فبفضل هذه العائدات، تستطيع الإمارات الاستمرار في بناء قواعدها، وتمويل عناصرها، واستقدام خبراء أجانب، دون الحاجة إلى ميزانية دفاعية رسمية، مما يمنحها مرونة استراتيجية وقدرة على المناورة في ملفات إقليمية متعددة. وهكذا تتحول الجزيرة من مجرد نقطة على الخريطة إلى أصل جيوسياسي مولّد للعائد والسيطرة في آن واحد، ضمن معادلة معقدة تدمج المال والأمن والاستخبارات، على حساب الشعب اليمني وسيادة الدولة.
التحالف الخفي في زقر: كيف تحوّلت الجزيرة إلى نقطة ارتكاز لعمليات عابرة للسيادة
تُعد جزيرة زقر واحدة من أكثر المواقع الجيوسياسية حساسية في البحر الأحمر، وتحتل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية إلى الغرب من مضيق باب المندب. وبرغم أن الاهتمام الإعلامي والسياسي تركز في السنوات الماضية على جزيرة ميون باعتبارها مركزًا للأنشطة العسكرية الإماراتية، فإن جزيرة زقر لم تكن غائبة عن المشروع الإماراتي الإسرائيلي المتكامل في البحر الأحمر، بل مثّلت قاعدة دعم لوجستي واستخباري موازٍ، أقل انكشافًا إعلاميًا لكنها أكثر عمقًا من حيث التخطيط طويل المدى. وتشير المعلومات الواردة من مصادر ملاحية، وصور الأقمار الصناعية التجارية، إلى أن جزيرة زقر شهدت منذ عام 2018 تحولات لافتة في بنيتها الجغرافية والعمرانية، تتجاوز الطابع المدني أو المؤقت، إلى بنى تحتية دائمة تحمل الطابع العسكري الصريح.
أولى المؤشرات على هذا التحول تمثلت في عمليات الردم الساحلي التي قامت بها سفن تابعة لشركات إماراتية مرتبطة مباشرة بالقوات البحرية، وهي عمليات غير مصرح بها من قبل الحكومة اليمنية أو منظمات البيئة البحرية، وأسفرت عن توسيع مساحة اليابسة في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة بمقدار يقدّر بحوالي 0.8 كم². هذا التوسيع تم توظيفه لاحقًا لإنشاء مدرج طائرات مُموَّه من نوع STOL (إقلاع وهبوط قصير)، مخصص لطائرات الاستطلاع الخفيف والطائرات بدون طيار متوسطة الحجم، ويُعتقد أن الطائرات التي تنطلق من هذا المدرج تشارك في عمليات مراقبة دائمة لحركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، وصولًا إلى خليج عدن من جهة، وقناة السويس من جهة أخرى.
وفي تطور عسكري نوعي، قامت القوات الإماراتية باستحداث مهابط مخصصة لطائرات الهجوم الأرضي من نوع AH-64 Apache، في الجهة الغربية من الجزيرة، باستخدام تقنية الردم الهيكلي بالخرسانة المسلحة، وتدريعها بألواح فولاذية خفيفة لتوفير الحماية من الهجمات الجوية أو القصف البحري المحتمل. وتُظهر الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية في نهايةوجود مهابط دائرية الطابع، مشغولة فعليًا بطائرات أباتشي إماراتية، ما يشير إلى انتقال نوعي في طبيعة المهام من الاستخبارات والمراقبة إلى القدرة على تنفيذ عمليات هجومية تكتيكية سريعة، سواء تجاه أهداف في السواحل اليمنية الغربية، أو في المجال البحري الإقليمي. وهذا يؤكد على أن زقر لم تعد مجرد نقطة مراقبة، بل باتت منصة انطلاق قتالية ضمن منظومة السيطرة الإماراتية في البحر الأحمر.
وبحسب مصادر استخباراتية فرنسية أوردتها صحيفة "لوموند" في تقرير نُشر في مارس 2024، فإن الوحدة الإماراتية المسؤولة عن عمليات الدعم في جزيرة زقر تعمل بتنسيق مباشر مع وحدة استخبارات بحرية إسرائيلية مرتبطة بوحدة شاييت 13 (Shayetet 13)، وهي وحدة النخبة في سلاح البحرية الإسرائيلي. وأفادت هذه المصادر أن فرقًا من الفنيين الإسرائيليين زارت الجزيرة في ثلاث مناسبات على الأقل خلال عامي 2021 و2023، تحت غطاء من "المساعدة التقنية في صيانة الأنظمة الدفاعية"، إلا أن تحليل نوع المعدات التي تم تركيبها يكشف عن منظومات تنصت بحرية ورادارات مراقبة مداها يتجاوز 250 كم، ما يعني أن الجزيرة لا تستخدم فقط كموقع سيادي، بل كمركز استخبارات متقدم يخترق حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتشير شهادات صادرة عن صيادين يمنيين أُجبروا على مغادرة المنطقة القريبة من زقر إلى أن الجزيرة خضعت لعملية إخلاء شاملة من السكان المحليين منذ أوائل عام 2019، مع فرض منطقة عسكرية محظورة لمسافة خمسة أميال بحرية حولها. وقد أفاد هؤلاء الصيادون بأنهم رصدوا في أكثر من مناسبة سفنًا غير يمنية تفرغ حاويات كبيرة في الميناء الجديد شرق الجزيرة، يُعتقد أنها معدات ذات طابع عسكري أو استخباري. وتؤكد هذه الإفادات التقارير التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" في نوفمبر 2023، والتي تحدثت عن وجود منظومة مراقبة بحرية إسرائيلية مثبتة على أعمدة فولاذية في الجزء الشمالي من الجزيرة، مغطاة بطبقات عازلة للرصد الحراري وتزود بالطاقة عبر ألواح شمسية ضخمة
في السياق نفسه، تبرز جزيرة زقر كجزء من مشروع التحكّم الإماراتي الإسرائيلي في العقد البحري الممتد من رأس الحد جنوب عمان حتى ميناء بورسودان في السودان، وهو المشروع الذي يندرج تحت ما يسمى "نظام العيون الزرقاء"، وهو مصطلح يُستخدم في مراكز الدراسات الإسرائيلية للإشارة إلى شبكة المراقبة والاستجابة السريعة التي تنشئها تل أبيب بالتعاون مع حلفائها على امتداد البحر الأحمر. وفي هذا السياق، يبدو أن زقر لا تؤدي فقط وظيفة دفاعية، بل يتم استخدامها لتخزين المعدات وتسهيل عمليات الإمداد للقواعد الأخرى، وعلى رأسها قاعدة ميون الجوية، مما يجعلها نقطة ربط لوجستي حيوية.
وما يثير القلق بشكل خاص هو المؤشرات المتزايدة على أن الجزيرة تحتوي على مركز احتجاز غير قانوني، وهو ما أشار إليه تقرير داخلي صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره للعام 2024، دون أن يذكر موقعه صراحة. التقرير تحدث عن "موقع ناءٍ في إحدى الجزر اليمنية يستخدم لاحتجاز أفراد يُشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة" دون محاكمة أو ضمانات قانونية. وقد لاحظ الفريق الأممي أن هذا الموقع يخضع لإدارة جهة غير يمنية، ولم يتمكن من زيارته لأسباب أمنية. تحليل الصور الجوية لمنشآت زقر يبيّن وجود مبنى مربع معزول وسط الجزيرة تحيط به أسوار عالية ومراقبة دائمة، بما يتطابق مع وصف مراكز الاحتجاز العسكري.
من الجانب التقني، تتكامل الأنظمة الموجودة في زقر مع شبكة الاتصال الفضائي التي تستخدمها الإمارات، والتي ترتبط بقمر "الياه سات" و"خليفة سات"، ما يتيح للقوات المتمركزة هناك إمكانية نقل البيانات اللحظية إلى مراكز القيادة في أبوظبي وتل أبيب. وتشير مصادر استخباراتية إلى أن هذه الأنظمة تُستخدم كذلك لتوجيه الطائرات بدون طيار التي تقوم بمهام رصد السفن، وربما توجيه عمليات هجومية بحرية مستقبلًا.
في سياق أوسع، فإن استخدام زقر بهذه الطريقة يمثل خرقًا واضحًا للسيادة اليمنية وانتهاكًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة احترام الحدود البحرية وعدم إنشاء قواعد عسكرية دون اتفاقات معلنة وشفافة. كما أن النشاط العسكري والاستخباري فيها يعكس تنسيقًا علنيًا بين الإمارات وإسرائيل يتجاوز نطاق "التطبيع" ليصل إلى مستوى **التحالف العسكري الحقيقي**، وهو ما يُعد سابقة في البحر الأحمر، ويهدد بشكل مباشر التوازن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية، ويعرّض السلم البحري لمخاطر حقيقية.
تُظهر الصور الجوية المقربة من جزيرة زُقَر تفاصيل دقيقة لاستحداثات عسكرية هندسية نفذتها الإمارات ضمن إطار التمركز غير المشروع في الجزيرة. الصورة الأولى تكشف بوضوح عن منشأة عسكرية مربعة كبيرة تضم أربع قواعد خرسانية موزعة بشكل متماثل، ويبدو أن كل قاعدة تحتوي على سطح معدني أو هيكل مصمم لتحمل الهبوط العمودي لطائرات مروحية ثقيلة مثل الأباتشي.
ويظهر في الزاوية اليسرى السفلى من المنشأة ممر ترابي منحني يربط المنطقة بشبكة الطرق الداخلية، وهو مؤشر على تخطيط مسبق لتسهيل الحركة الميدانية داخل القاعدة.
وجود خندق ترابي أو حاجز دفاعي خفيف على الأطراف، بالإضافة إلى بُنية إسمنتية محصّنة في الركن الشمالي الغربي، يشير إلى أن المنشأة ليست مخصصة للهبوط فقط، بل يُحتمل أنها تحتوي على غرفة قيادة أو مركز عمليات ميداني.
التوزيع المتناظر للمهابط، والمسافات الفاصلة بينها، ينسجم مع الاشتراطات العسكرية لتمركز طائرات الأباتشي من حيث نصف قطر الدوران وأمان الإقلاع والهبوط. كما تلاحظ آثار سواد أو احتراق أرضي في الزاوية الشمالية الغربية، وهو مؤشر معروف على نشاط حراري متكرر ناتج عن هبوط مروحيات قتالية.
أمام هذه الحقائق، تُعد زقر شاهدًا صامتًا على التحول العميق الذي يطرأ على طبيعة الصراع في البحر الأحمر، من صراع على النفوذ إلى صراع على البنى التحتية السيادية. ولم تعد الجزيرة مجرد نقطة جغرافية ذات أهمية، وانما تحولت إلى عقدة في شبكة أمنية وجيوسياسية معقدة، تتداخل فيها أطماع السيطرة، وعوالم الاستخبارات، ومشاريع إعادة رسم خرائط النفوذ في جنوب البحر الأحمر.
البعد الجيوسياسي والاستراتيجيات الإقليمية والدولية في ميون وزقر
يكتسب البعد الجيوسياسي لجزيرتي ميون وزقر أهمية حاسمة ضمن التنافس الإقليمي والدولي على الممرات البحرية الحيوية، وخصوصًا مضيق باب المندب الذي يُعد بوابة البحر الأحمر نحو المحيط الهندي. لا تنبع أهمية هذه الجزر فقط من موقعها الجغرافي كجزء من الأرخبيل اليمني، بل من قدرتها على التحكم النسبي بحركة الملاحة الدولية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على هذا المسار لنقل النفط، والسلع التجارية، والعمليات العسكرية في مسارح متعددة تمتد من الخليج العربي حتى الساحل الشرقي لإفريقيا. هذا الوضع جعل جزيرتي ميون وزقر محورًا لصراع خفي بين قوى إقليمية متعددة تتقدمها الإمارات وإسرائيل من جهة، وإيران وتركيا من جهة أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة والصين اللتين تتنافسان على تأمين قواعد نفوذ بحرية في المحيط الهندي وما حوله
التحركات الإماراتية في جزيرة ميون ليست معزولة عن هذا السياق، بل تأتي في إطار استراتيجيتها الأوسع لتكريس حضور بحري مستدام يمتد من ميناء الفجيرة حتى خليج عدن، ومنه إلى القرن الإفريقي عبر قاعدة عصب في إريتريا. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تسير وفق مقاربة “الارتكاز المرحلي”، حيث تُبنى نقاط تموضع قابلة للتوسع التدريجي، تبدأ بعمليات إنسانية أو تحركات تحالفية، ثم تتطور إلى قواعد عسكرية واستخباراتية متكاملة، ما يسمح للإمارات بتعزيز حضورها دون الحاجة إلى صدامات مباشرة أو إعلانات رسمية قد تُعرّضها للمساءلة الدولية.
جزيرة ميون، نظرًا لموقعها في قلب مضيق باب المندب، تشكل بالنسبة للإمارات ما يشبه “مفتاح السيطرة” على حركة الشحن العالمية، إذ يمكن من خلالها مراقبة أو حتى تعطيل أي حركة بحرية تمر بالمضيق. وهذا ما يفسر المساعي الحثيثة لبناء منظومات مراقبة بحرية متطورة في الجزيرة، ترتبط بشبكة أوسع تضم قاعدة عصب، والموانئ التي تسيطر عليها الإمارات في عدن والمخا، وحتى نقاط في سقطرى. هذا الربط المتعدد يُمكّن الإمارات من فرض نوع من “التحكم الجوي–البحري–الاستخباراتي” غير المعلن، يجعل من كل حركة بحرية تحت المراقبة، سواء كانت سفينة تجارية أو ناقلة نفط أو قطعة بحرية عسكرية
في المقابل، تنظر إسرائيل إلى الجزيرة كفرصة استراتيجية نادرة لتحقيق ثلاثة أهداف متداخلة. الأول هو التمركز في موقع يسمح لها بمتابعة النشاط الإيراني في البحر الأحمر، خصوصًا بعد تزايد الشحنات البحرية بين إيران وسوريا ولبنان عبر هذا المسار. الثاني هو التوسع في منطقة نفوذ جديدة تُكمل تموضعها المتزايد في الخليج العربي بعد اتفاقات التطبيع، وتمنحها منصة لوجستية قريبة من شرق إفريقيا، حيث بات لها حضور استخباراتي نشط في إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا. أما الهدف الثالث فهو إنشاء خط دفاع استباقي ضد أي تهديد محتمل من حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) أو القوات الإيرانية المتحالفة معها، عبر وجود استطلاعي وهجومي مشترك مع الإمارات يمكن تفعيله في أي لحظة.
كل هذه التحركات أثارت بطبيعة الحال قلقًا متزايدًا من أطراف إقليمية مثل إيران، التي ترى في الحضور الإماراتي–الإسرائيلي المشترك تهديدًا مباشرًا لأمنها البحري، خاصة وأن خطوط إمدادها إلى البحر المتوسط تمر بهذا المضيق. وقد دفعت هذه المخاوف طهران إلى زيادة نشاطها البحري في البحر الأحمر، بما في ذلك إرسال سفن استطلاع وتدخل مثل السفينة “ساويز” التي تم استهدافها لاحقًا. كما بدأت بتعزيز تعاونها مع الحوثيين في مجال الدفاع الساحلي والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، كجزء من ردع أي تهديد محتمل من جهة ميون أو الساحل الغربي.
تركيا بدورها تنظر بقلق إلى التمدد الإماراتي في جزيرة ميون، خاصة في ظل التوترات الحاصلة بين أنقرة وأبوظبي في ملفات متعددة من ليبيا إلى القرن الإفريقي. وقد بدأت تركيا بإعادة تفعيل علاقاتها مع الصومال وجيبوتي، وبناء قاعدة تدريب بحرية في مقديشو، كجزء من محاولة احتواء النفوذ الإماراتي المتزايد. كما تعزز تركيا حضورها في البحر الأحمر عبر مناورات عسكرية مشتركة مع السودان قبل الانقلاب الأخير، إضافة إلى إرسال سفن مراقبة تحت غطاء إنساني أو تدريبي. هذا التنافس يُظهر كيف أن السيطرة على جزيرة صغيرة مثل ميون باتت نقطة تماس استراتيجي بين معسكرات متعددة، قد تنزلق في أي لحظة إلى صدامات غير مباشرة، أو حروب ظلّ بالوكالة.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فإن موقفها يبدو أكثر غموضًا، إذ على الرغم من معرفتها الدقيقة بما يجري في جزيرة ميون، كما تؤكد الوثائق المسربة، فإنها اختارت الصمت أو التواطؤ، ربما لأنها تعتبر التمركز الإماراتي–الإسرائيلي جزءًا من ترتيبات أمنية إقليمية تخدم المصالح الأمريكية في المدى المتوسط. وقد اعتمدت واشنطن في السنوات الأخيرة على استراتيجية “التفويض بالوكالة”، حيث تترك لحلفائها الإقليميين تنفيذ المهام القذرة، بشرط ضمان التنسيق والتفاهم الاستراتيجي معها. وهو ما يظهر في طريقة تعاطيها مع الملف اليمني برمّته، حيث تكتفي بإرسال إشارات ضغط حينًا، وغض الطرف أحيانًا، دون تبني موقف مبدئي واضح تجاه السيادة اليمنية أو التجاوزات الإماراتية.
الصين من جهتها تراقب المشهد عن كثب، نظرًا لكونها تعتمد على مضيق باب المندب في 40% من وارداتها النفطية، كما أن طريق الحرير البحري الذي تسعى لتأمينه يمر من هذا المضيق. وعلى الرغم من عدم إعلان الصين أي موقف رسمي تجاه ما يجري في ميون، إلا أن تحليل خطواتها الاستراتيجية، مثل التمركز في جيبوتي، وتشغيل موانئ في باكستان وسريلانكا، يشير إلى أنها تتجه لبناء منظومة ردع غير معلنة، قد تتطور لاحقًا إلى شبكة قواعد بحرية تحيط بالممرات الحيوية، بما في ذلك باب المندب. ولعل تزايد حضور الشركات الصينية في موانئ البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات صيانة وتطوير، يمثل نوعًا من الحضور الناعم الذي قد يتعزز لاحقًا بأبعاد أمنية وعسكرية.
من منظور يمني، فإن ما يحدث في جزيرة ميون وزقر يُمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي اليمنية، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار الدولة المركزية. الغياب الكامل للحكومة اليمنية عن هذا الملف، وعدم اتخاذها أي موقف قانوني دولي فاعل، جعل من هذه الجزر بيئة خصبة للتلاعب الإقليمي والدولي. ومما يزيد الطين بلّة، هو أن بعض الأطراف المحلية اليمنية، مثل قوات طارق صالح، باتت جزءًا من هذه المعادلة، حيث يتم توظيفها كقوات حراسة أو تنفيذ عمليات بالوكالة، ما يعني تورطًا محليًا في مشروع فقدان السيادة.
إن البعد الجيوسياسي لجزيرتي ميون وزقر يكشف عن طبيعة الصراعات الجديدة التي لم تعد تُخاض عبر الجيوش التقليدية، بل عبر التمركز الذكي، والحرب الاستخباراتية، والهيمنة البحرية الصامتة. وهذا النمط من السيطرة يُعيد تعريف مفهوم الاحتلال، حيث تتحكم الدول الكبرى في مفاصل جغرافية حيوية، دون الحاجة إلى إعلان رسمي أو اعتراف قانوني، بل عبر تحالفات محلية، وتواطؤ دولي، وتحويل الأزمات إلى فرص نفوذ. وإذا لم تتم مواجهة هذا المسار بخطوات يمنية قانونية، وإقليمية موحدة، فإن باب المندب بأكمله قد يتحول إلى منطقة نفوذ خارجية بالكامل، تُمثل خطرًا ليس فقط على اليمن، بل على الأمن القومي العربي، والتوازن الاستراتيجي العالمي في واحدة من أخطر مناطق الملاحة البحرية في العالم.
البعد البنيوي للتحركات الإماراتية الإسرائيلية في البحر الأحمر
إن التداخل المتزايد بين النشاط العسكري والسياسي لدولة الإمارات في جزيرتي ميون وزقر لا يمكن عزله عن السياق الأوسع لإعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وهو ما يكشف عن بُعد بنيوي أعمق يتجاوز مجرد السيطرة على مواقع جغرافية استراتيجية، ليطال إعادة تعريف مفاهيم السيادة الوطنية، وموازين القوى البحرية، وخطوط النفوذ غير التقليدي. إن هذا الدور المتنامي لا يُعبر فقط عن طموحات إماراتية في توسيع مجالها الحيوي، بل يندرج ضمن ما يمكن تسميته بـ"عقيدة الموانئ العسكرية" التي اعتمدتها أبوظبي خلال العقد الأخير، والتي تقوم على بناء شبكة قواعد ساحلية وجزرية تمتد من الخليج العربي إلى سواحل الصومال وإريتريا واليمن، بهدف تشكيل طوق نفوذ مائي يشبه الطوق الأمني الذي أنشأته الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين أثناء الحرب الباردة
وقد مثّلت ميون وزقر في هذا السياق نقطتين محوريتين في هذا المشروع، نظرًا لما توفرانه من قدرة على التحكم الفوري في مداخل ومخارج باب المندب، وما يتيحه ذلك من امتيازات جيوسياسية لا تتوفر حتى للدول الكبرى، إذ يكفي أن تتمكن الإمارات من تعطيل الملاحة في هذا الممر لأيام معدودة حتى ترتفع تكاليف الشحن العالمي بنسبة قد تفوق 30%، ويتأثر أمن الطاقة في أوروبا وآسيا بشكل مباشر. من هنا تتضح الأسباب الحقيقية للتمسك الصارم من قبل أبوظبي بهذه المواقع، حتى في ظل تصاعد الانتقادات الدولية أو الدعوات اليمنية الرسمية للانسحاب. كما أن هذا التمسك يعكس قناعة إماراتية راسخة بأن معارك النفوذ في القرن الحادي والعشرين لا تُحسم فقط بالقوة العسكرية التقليدية، بل بالسيطرة على العقد الجغرافية التي تُعد بمثابة "أزرار التحكم" في حركة التجارة العالمية وتوازنات الطاقة.
ولا تقتصر خطورة هذا المشروع على طموحات الإمارات وحدها، بل تمتد إلى طبيعة الشراكات الدولية التي تعتمد عليها في تحقيقه، حيث دخلت إسرائيل، بعد توقيع اتفاقية التطبيع، كلاعب غير ظاهر بشكل مباشر لكنه محوري على مستوى التخطيط والتقنية وتبادل المعلومات. وقد أظهرت تقارير استخباراتية أن خبراء إسرائيليين في مجال الاتصالات المشفرة والاستشعار الراداري عملوا إلى جانب الضباط الإماراتيين في بناء بنية تحتية رقمية تشمل أنظمة كشف متقدمة تُزرع في قاع البحر لمراقبة حركة الغواصات، ونشر طائرات مسيّرة على مدار الساعة لرصد أي تحركات بحرية غير مصرح بها. هذه الأنظمة لا تُمكّن الإمارات فقط من فرض سيادتها الافتراضية على مضيق باب المندب، بل تمنح إسرائيل كذلك بوابة مراقبة متقدمة عند مدخل البحر الأحمر، وهو ما يُعد تحولاً جذريًا في موازين القوى الإقليمية.
من الناحية الجيوستراتيجية، يمثّل هذا التمركز جزءًا من تحالفات غير رسمية قيد التشكّل، تشمل الإمارات، إسرائيل، السعودية، ودوائر تأثير في الولايات المتحدة، تهدف إلى خلق "ممر آمن بديل" للنفط والغاز الخليجيين في حال تصاعد التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز. وتُشير معلومات من دوائر أمنية غربية إلى أن بعض المناورات العسكرية التي أجريت قرب السواحل الإريترية واليمنية خلال الأعوام الماضية كانت تهدف لاختبار سيناريوهات تعطيل الملاحة في هرمز، وتحويل خط التصدير عبر باب المندب – قناة السويس – البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بميناء العقبة أو خطوط الأنابيب الجديدة التي يتم تشييدها بين السعودية والأردن. وفي هذا السياق، تصبح جزيرة ميون بمثابة "عقدة تأمين"، أي نقطة سيطرة تضمن بقاء هذا الخط الاستراتيجي مفتوحًا في مواجهة أية مخاطر
ويُضاف إلى هذا البعد الجيوسياسي بُعد آخر لا يقل خطورة، يتمثل في النزعة إلى إعادة تعريف السيادة اليمنية نفسها. فبناء قواعد عسكرية، وتشغيل سجناء، وتوقيع عقود مع شركات أجنبية دون تفويض حكومي أو علم برلماني، يُمثل خروجًا تامًا عن مبدأ احترام الحدود والسيادات، كما يُعيد إحياء نموذج "الاحتلال الناعم" الذي لا يقوم على الجيوش النظامية الكلاسيكية بل على التغلغل المؤسساتي والتقني والاقتصادي. وتُظهر وثائق متعددة أن العقود المبرمة في ميون وزقر تتضمّن بنودًا تمنح الشركات الإماراتية والإسرائيلية صلاحيات حصرية في التشغيل والإدارة لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، دون أية التزامات تُذكر تجاه الدولة اليمنية، لا في شكل ضرائب، ولا رسوم، ولا حتى تقارير دورية للرقابة أو المساءلة
إن هذه التحركات لا تُفهم فقط ضمن إطار التوسّع العسكري، بل أيضًا ضمن سياق التنافس على الفضاءات البحرية العالمية، حيث تُدرك الدول الصغيرة ذات الإمكانات المالية الكبيرة، مثل الإمارات، أن الدخول في مضمار التأثير العالمي لا يتطلب بالضرورة حيازة جيوش ضخمة، بل يكفي توظيف التكنولوجيا، والشراكات الأمنية، والتموضع الذكي في نقاط الاحتكاك الجغرافي. وهذا ما يفسر تركيز أبوظبي على الجزر، والموانئ، والمضائق، باعتبارها أدوات للقوة الناعمة الصلبة hybrid power التي تجمع بين الردع العسكري والهيمنة الاقتصادية.
ومما يعزز هذا التحليل أن الإمارات لا تستخدم ميون وزقر فقط كمواقع عسكرية، بل تعمل على تحويلهما إلى مراكز اتصال بين مشروعها في البحر الأحمر، وشبكتها في القرن الإفريقي، خاصة في الصومال وجيبوتي وإريتريا، حيث تمتلك قواعد أو اتفاقيات طويلة الأمد. هذه المراكز تتيح لها تتبع حركة الأساطيل الأجنبية، والقيام بعمليات استخباراتية مشتركة، أو حتى شن عمليات خاصة في دول ثالثة، دون المرور بأي موافقة دولية أو برلمانية، وهو ما يُعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. كما أن هذا التموقع يخدم مشروعًا أوسع يعرف باسم "الربط البحري المتوسطي–الهندي"، والذي يهدف إلى خلق سلسلة من المحطات والمراكز المرتبطة رقميًا وعملياتيًا، تكون قادرة على توليد تدفق معلوماتي دائم يخدم مصالح التحالف الإماراتي–الإسرائيلي في المدى المتوسط والطويل.
إن هذا البعد الجيوسياسي المتقدم لما يجري في جزيرتي ميون وزقر يفرض على اليمن، ودول الإقليم، والمجتمع الدولي، إعادة النظر في طبيعة التعامل مع هذه الملفات، باعتبارها قضايا تتجاوز البُعد الوطني الضيق، وتمس مباشرة بالأمن الجماعي للبحر الأحمر، وبحر العرب، وخطوط الطاقة العالمية. إذ إن ترك هذه التحركات دون محاسبة أو رقابة، يُعد بمثابة تفويض غير مباشر لبناء واقع استعماري جديد بأدوات حديثة، ما قد يفتح المجال لسباق تسلّح بحري في المنطقة، أو لتدخلات خارجية أكثر حدة في المستقبل القريب.
الأثر السيادي والقانوني على الجمهورية اليمنية
لم يعد بالإمكان قراءة الحضور العسكري والسياسي الإماراتي في جزيرتي ميون وزقر بمعزل عن السياق القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية، فكل ما يجري من عمليات بناء قواعد عسكرية، وتوظيف استثمارات أمنية، وإبرام اتفاقيات سرية مع أطراف خارجية كإسرائيل، يجري دون علم أو موافقة الدولة اليمنية، بل في ظروف انهيار مؤسساتها الرسمية وانشغالها بالحرب. هذا يجعل من الوجود الإماراتي هناك تجاوزًا صريحًا لمفاهيم السيادة الوطنية المتعارف عليها في القانون الدولي، ويحوّل الجزر اليمنية إلى مناطق خارجة عن السيطرة الفعلية للدولة، ويدشن سابقة خطيرة في العلاقات الدولية المعاصرة، مفادها: أن القوة العسكرية والفراغ السياسي يسمحان بإعادة ترسيم الخرائط الجيوسياسية دون الحاجة إلى اعترافات دولية أو مفاوضات سيادية.
إن الدستور اليمني، كما سائر الدساتير السيادية في العالم، لا يجيز لأي جهة حكومية – فضلًا عن غير الحكومية – التنازل عن أي جزء من التراب الوطني، أو السماح بإقامة منشآت عسكرية أجنبية دون إذن من البرلمان المنتخب وموافقة رسمية موثقة. وبناء عليه، فإن أي وجود عسكري لدولة أجنبية، بما في ذلك الإمارات، على الأراضي اليمنية، دون اتفاقية سيادية معلنة ومصدق عليها، يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، وخرقًا لمبادئ القانون الدولي العام، خصوصًا ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرّم احتلال أراضي الغير أو فرض السيطرة بالقوة على مواقع ذات سيادة
الأمر الأكثر خطورة أن هذا التمركز العسكري لم يكن نتيجة احتلال تقليدي واضح المعالم يمكن التعامل معه وفق القوانين الدولية التي تنظم حالة الاحتلال، بل جاء في سياق تحالف عسكري يُفترض أن هدفه دعم الشرعية اليمنية. إلا أن الواقع أثبت أن الإمارات استخدمت غطاء التحالف لتصفية حساباتها الجيوسياسية وتوسيع نفوذها في البحر الأحمر، ثم انقلبت تدريجيًا على أهداف التحالف، وشرعت في بناء مشروع موازٍ للدولة اليمنية، يوظف أدوات محلية موالية، ويعمل على تقويض السيادة المركزية من الداخل، لا فقط من الخارج.
هذا التمدد الإماراتي لم يكن ليأخذ هذا الزخم لولا الفجوة القانونية والسياسية التي خلقتها الحرب، وغياب أي سلطة قضائية أو رقابية قادرة على ملاحقة الانتهاكات، فضلاً عن وجود صمت دولي غير مبرر، وتواطؤ ضمني من بعض الدول الكبرى التي ترى في التحركات الإماراتية عامل توازن في وجه خصوم إقليميين مثل إيران أو تركيا. لكن هذا الصمت لا يمنح المشروعية القانونية، بل يؤكد أن القانون الدولي يُستخدم أحيانًا كأداة سياسية بيد القوى المتنفذة، وليس كمرجعية ملزمة للجميع.
من الناحية الإجرائية، لم يتم الإعلان عن أي اتفاق يخول الإمارات إقامة قواعد في ميون أو زقر. ولم تصدر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا – رغم ضعفها – أي تفويض صريح بذلك. بل إن العديد من المسؤولين اليمنيين السابقين والضباط المنشقين أكدوا أن ما يحدث يتم خارج الأطر الرسمية، بل ويُفرض كأمر واقع من خلال سياسات الابتزاز، ومنح الولاءات، وتهميش السلطات المحلية. هذا يُعيدنا إلى مفهوم "السيادة المنقوصة" أو "السيادة المعطلة"، حيث تتواجد دولة على الورق، لكن لا تملك فعليًا سلطة اتخاذ القرار في مناطقها الحيوية.
ومما يفاقم الأزمة السيادية أن الإمارات لا تتصرف بوصفها دولة ضامنة أو متحالفة، بل كقوة مقرّرة تبني تحالفاتها الخاصة مع فصائل يمنية محددة، وتفرض من خلالها سياسة أمر واقع، وتحرم الدولة المركزية من حقها الحصري في تقرير مصير أراضيها ومرافقها الحيوية. هذا النوع من النفوذ يُخرج الجزر عن المدار السيادي للدولة اليمنية، ويضعها ضمن مجال نفوذ دولة أجنبية، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا. والنتيجة هي ولادة "مناطق رمادية" في السيادة، حيث تتآكل سلطة الدولة تدريجيًا لصالح مشروع احتلال غير معلن.
كما أن إدخال إسرائيل كشريك فعلي في بناء البنية العسكرية في ميون، يمثل خرقًا مضاعفًا للسيادة، نظرًا لأن اليمن لا تعترف بإسرائيل، ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية، فضلًا عن أن طبيعة الصراع العربي–الإسرائيلي، وما يحمله من تعقيدات، تجعل من أي شراكة مع تل أبيب داخل أراضي دولة عربية أمرًا ذا تداعيات خطيرة. هذا لا يمثل فقط خرقًا للسيادة، بل طعنًا في العمق السياسي والتاريخي للموقف اليمني، وتحولًا جوهريًا في المعادلة الجيوسياسية للمنطقة.
إن الإطار القانوني الدولي يُجرم الاحتلال غير المعلن، ويفرض على الدول التزامات واضحة حال دخول أراضي دولة أخرى، سواء من حيث إعلان نوايا، أو توقيع اتفاقيات مؤقتة، أو احترام البنية السيادية للدولة المتواجدة على أراضيها. لكن الإمارات – مدفوعة بحسابات الهيمنة – تجاهلت هذه المبادئ، وخلقت نموذجًا سياديًا هجينًا، يقوم على وجود أمني واستخباراتي صلب، دون أي شرعية قانونية أو دبلوماسية. وهو ما يضعها أمام مسؤولية قانونية دولية، خاصة إذا أُعيد تفعيل ملف السيادة اليمنية في المحاكم الدولية مستقبلًا.
الأثر القانوني لهذا الانتهاك لا يقتصر على الإمارات، بل يمتد ليشمل شركاءها الإسرائيليين، وكذلك الدول التي تسهل هذا التمركز بصمتها أو دعمها غير المباشر. وهذا يفتح الباب لمساءلات قانونية قد تُستخدم كورقة ضغط في مراحل لاحقة، خاصة إذا تغيرت موازين القوى، أو تشكلت حكومة يمنية جديدة تملك الإرادة والشرعية لملاحقة هذه الانتهاكات. فكل عقد أُبرم، وكل منشأة أُقيمت، وكل نشاط أمني جرى على هذه الجزر دون موافقة الدولة اليمنية، يمكن تصنيفه كأعمال غير مشروعة قابلة للطعن أمام هيئات التحكيم الدولية.
على الصعيد المحلي، فإن غياب السيطرة اليمنية على جزرها الحيوية، يُضعف من موقفها التفاوضي في أي تسوية سياسية قادمة، إذ سيُطرح سؤال مركزي: هل الدولة اليمنية تملك فعليًا القرار في مواقعها الاستراتيجية؟ وإذا لم تكن تملك ذلك، فما قيمة أي اتفاق سياسي لا يشمل استعادة هذه المواقع؟ وبالتالي، فإن فقدان السيادة لا يعني فقط خسارة الأرض، بل خسارة الدور والوزن في المعادلات الإقليمية.
إن ما يجري في ميون وزقر يجب أن يُقرأ بوصفه إنذارًا مبكرًا لتفكيك السيادة اليمنية، وإعادة تشكيل خريطة التحكم البحري في المنطقة بوسائل ناعمة وهجينة، تستخدم فيها القوة العسكرية، والمال السياسي، والتحالفات الانتقائية، دون الحاجة إلى رفع أعلام الاحتلال. وهذا يتطلب تحركًا عاجلًا من النخب اليمنية، ومن القوى السيادية، ومن المؤسسات الأممية التي لا تزال تدّعي احترام السيادة الوطنية للدول، للوقوف بوجه هذا النمط الجديد من تقويض الدول من الداخل والخارج في آن واحد.
المشروع الإماراتي الإسرائيلي لإعادة هندسة التوازنات في البحر الأحمر
تُعد السيطرة على جزيرتي ميون وزقر من قبل الإمارات، بمشاركة إسرائيلية خفية، جزءًا من مشروع أوسع يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للبحر الأحمر، بما يتجاوز الاعتبارات الأمنية الظاهرة، ليمتد إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية ذات طابع استيطاني طويل الأمد. هذا التمركز العسكري غير المعلن ليس إجراءً ظرفيًا، بل هو خطوة محسوبة ضمن سلسلة من التحركات التي تهدف إلى إعادة تعريف التوازن الإقليمي، والتحكم في مفاصل التجارة الدولية، وخلق شبكة نفوذ تمتد من أبوظبي إلى تل أبيب، مرورًا بالمضائق والموانئ الحيوية. وإذا كانت السيطرة على الممرات البحرية تعد هدفًا تقليديًا للدول الكبرى، فإن ما تفعله الإمارات حاليًا يرقى إلى محاولة فرض أمر واقع جديد يطيح بالتوازنات القديمة ويُقصي الأطراف الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها اليمن، عن دائرة التأثير في مياهها السيادية.
فمن خلال بناء قاعدة عسكرية مكتملة في جزيرة ميون، والانتشار في جزيرة زقر، وتثبيت وحدات مراقبة في النقاط المرتفعة، تحوّل الإمارات هذه الجزر إلى "مفاتيح استراتيجية" تشكل عقدًا مركزية في شبكة نفوذ بحرية عابرة للحدود. وهذا التحول لا يمكن فصله عن التنافس الدولي على ممرات الطاقة والشحن، إذ أن موقع ميون تحديدًا عند مضيق باب المندب يجعل منها نقطة ارتكاز مثالية لرصد وإعادة توجيه حركة السفن التجارية، وحتى التدخل في تدفق الموارد الاستراتيجية في حالات التوتر أو النزاع. وما يزيد الأمر خطورة أن هذه السيطرة تتم بالتنسيق مع إسرائيل، وهو ما تؤكده الوثائق الفنية المسرّبة، وشهادات الطيارين العسكريين الذين كشفوا عن وجود مشترك في غرف القيادة، وعن زيارات سرية لخبراء إسرائيليين إلى الجزيرة، بما يؤسس لبنية أمنية جديدة خارج إطار النظام العربي التقليدي.
لا تقتصر خطورة هذا التموضع على الجانب العسكري والاستخباراتي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن الإمارات، وعبر شركات وسيطة، بدأت باستثمار البنية البحرية في ميون وزقر كموانئ بديلة ذات طابع خاص، يتم استخدامها لتسهيل عمليات تجارية غير خاضعة للرقابة الجمركية اليمنية، وتشمل عمليات تهريب أسلحة إلى مجموعات موالية، وتهريب سلع استراتيجية من اليمن إلى الخارج دون علم الحكومة. وقد جرى في هذا السياق توقيع اتفاقيات تشغيل خاصة مع شركات بحرية تديرها شخصيات إماراتية تحمل جنسيات مزدوجة، يتم من خلالها تسيير خطوط شحن بحرية غير معلنة إلى موانئ في إريتريا وجيبوتي، مما يضعف من قدرة الدولة اليمنية على السيطرة على ثرواتها وعلى عمليات التصدير والاستيراد.
في الوقت نفسه، بدأت الإمارات بتنفيذ ما يُشبه "التحول الديموغرافي المحدود" في بعض النقاط القريبة من زقر، عبر استقدام عناصر غير يمنية، وتوطينهم بصفة عمال فنيين، فيما تشير الشهادات الميدانية إلى أن هؤلاء الأفراد يخضعون لتدريبات عسكرية غير معلنة، ويتمتعون بامتيازات خاصة لا يحصل عليها السكان المحليون. هذا الشكل من الاستيطان العسكري يُذكرنا بمشاريع الاحتلال البحري التي مارستها قوى استعمارية تاريخية، ويؤكد أن ما يجري في هذه الجزر ليس مجرد وجود عسكري مؤقت، بل مشروع استقرار جيوسياسي مدروس يهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض، يستند إلى التفوق التكنولوجي والغطاء السياسي الذي توفره التطبيع العلني مع إسرائيل.
الأكثر من ذلك أن الإمارات لم تعد تكتفي بتثبيت وجودها، بل بدأت بالتعامل مع هذه الجزر باعتبارها جزءًا من مجالها الحيوي، فتقوم بمنع أي باحثين يمنيين أو صحفيين من الاقتراب من المنطقة، وتفرض حظرًا بحريًا غير معلن تديره زوارقها المسلحة، وتتحكم بحركة الطيران المدني والعسكري في محيط الجزيرة، حتى أن بعض الشركات الدولية أبلغت موظفيها بعدم محاولة الاقتراب من المجال البحري حول ميون إلا بعد التنسيق مع سلطة ملاحية مرتبطة بالإمارات. كل ذلك يتم في ظل غياب تام لأي تمثيل رسمي للدولة اليمنية، ودون وجود أي إشراف أممي أو دولي، ما يجعل من هذه السيطرة نموذجًا واضحًا للاحتلال بالوكالة، الذي يجري تحت عباءة التحالف تارة، وتحت ذرائع محاربة الإرهاب أو تأمين الملاحة تارة أخرى.
أما على الصعيد السياسي، فإن هذا التوسع الإماراتي يتزامن مع محاولات حثيثة لتثبيت وكلاء محليين موالين في الحكومة اليمنية، أو في المجالس المحلية القريبة من باب المندب، ويتم استخدام النفوذ العسكري في الجزر كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، بهدف فرض أجندات أبوظبي في أي تسوية مستقبلية للحرب في اليمن. هذا يعني أن هذه الجزر لم تعد مجرد مواقع جغرافية، بل تحوّلت إلى أدوات تفاوض استراتيجية، يتم عبرها هندسة مخرجات العملية السياسية في اليمن، وبما يضمن أن تبقى الإمارات شريكًا ضروريًا لا يمكن تجاوزه، سواء بقي التحالف العربي أو تفكك.
من الناحية القانونية، فإن هذه السيطرة تمثل خرقًا واضحًا لكل القوانين الدولية التي تحظر على أي دولة استخدام القوة أو التهديد بها للاستيلاء على أراضٍ تحت سيادة دولة أخرى، حتى في ظروف الحرب. ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الجزر الواقعة ضمن المياه الإقليمية لأي دولة، تُعد جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولا يجوز إنشاء قواعد عسكرية عليها دون تفويض رسمي من السلطة المركزية. كما أن استخدام هذه الجزر لشن عمليات ضد دول ثالثة أو لرصد حركة التجارة العالمية دون تنسيق مع الأمم المتحدة، يُعد تجاوزًا صريحًا لمبدأ الأمن الجماعي، ويُحول البحر الأحمر من منطقة عبور آمنة إلى بؤرة صراع إقليمي–دولي محتمل.
بالمقابل، لا تزال الحكومة اليمنية عاجزة عن مواجهة هذا التمدد، إما بسبب الانقسام الداخلي، أو نتيجة الضغوط التي تمارسها أطراف دولية ترى في الدور الإماراتي عنصرًا ضروريًا لضبط التوازنات في البحر الأحمر، خاصة مع التراجع الأمريكي الجزئي عن إدارة الأمن البحري، وصعود قوى أخرى كالصين وروسيا. وهذا الفراغ يتم ملؤه حاليًا بمبادرات فردية من دول الخليج، إلا أن ما تفعله الإمارات يتجاوز "ملء الفراغ" ليصبح "إعادة تشكيل" كامل للمنطقة، تحت مظلة التحالف حينًا، وبالتواطؤ مع تل أبيب حينًا آخر، ما يضع مستقبل الأمن القومي اليمني والعربي في مهبّ الريح.
من خلال ماسبق نؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يجري في ميون وزقر لا يمكن فهمه كتحرك عسكري تقني، بل كعملية متكاملة ذات أبعاد جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية، تهدف إلى إعادة هندسة موازين القوى في البحر الأحمر من جهة، وترسيخ دور إسرائيل كشريك أمني مباشر في الإقليم من جهة أخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة من جميع القوى اليمنية، وإعادة تعريف أولويات السيادة، وبناء مشروع وطني جامع يُعيد الدولة إلى جزرها، ويمنع تحويل المياه اليمنية إلى منصات للتجسس والتدخلات الأجنبية.
الدور الإسرائيلي في جزيرتي ميون وزقر
في هذا البند الأخير، سيتم تحليل الدور الإسرائيلي في جزيرتي ميون وزقر ليس فقط كامتداد لدورها الاستخباراتي والتقني والعسكري، بل كبنية وظيفية متكاملة تعكس تطور العقيدة الإسرائيلية تجاه نقاط الاختناق البحرية الاستراتيجية خارج حدودها المباشرة. إن الحضور الإسرائيلي في البحر الأحمر لم يعد مجرد تعاون عسكري ثانوي أو دعم استخباراتي لدولة خليجية، بل أصبح جزءًا من استراتيجية توسعية متعددة الأذرع، تقوم على التغلغل الناعم تحت مظلة الشركاء الخليجيين الذين يوفّرون الغطاء السياسي والتمويل، في حين توفّر إسرائيل التكنولوجيا، الاستخبارات، وإدارة العمليات المركّبة التي لا يمكن للإمارات أو غيرها من الدول الخليجية تنفيذها وحدها في بيئة معقدة كاليمن.
تؤكد التقارير المتقاطعة أن التواجد الإسرائيلي في جزيرة ميون لم يبدأ بعد اتفاقيات التطبيع، بل سبقه تعاون استخباراتي طويل الأمد مع الإمارات منذ عام 2016 على الأقل، غير أن اتفاقية إبراهيم قد شكّلت نقطة تحوّل جعلت من هذا التعاون علنياً ومنظماً، بما في ذلك إنشاء وحدات عمليات إلكترونية مشتركة، وتبادل ضباط في غرف القيادة والتحكم، وتدريب القوات المحلية اليمنية على يد مدربين إسرائيليين بصفة "مستشارين تقنيين". هذه المهام شملت تهيئة فرق الاقتحام البحري، ووحدات الحرب السيبرانية، وتدريب فنيين يمنيين على تشغيل أنظمة رصد ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعرّف على الأنماط من صور الأقمار الصناعية
التحركات الإسرائيلية كانت مبنية على فهم عميق لهشاشة الدولة اليمنية، وتفكك الجغرافيا السياسية للبلاد، وضعف السلطة المركزية، مما يخلق فراغًا استراتيجيًا يمكن ملؤه بهدوء عبر أدوات غير تقليدية. وقد تم استثمار هذا الفراغ بشكل موجه، بحيث أصبح البحر الأحمر نفسه، من باب المندب وحتى جزيرة زقر، مجالًا اختبارياً لبنية سيطرة إسرائيلية–خليجية–أميركية مشتركة، تتقاطع مصالحها حول ضمان انسياب التجارة، عزل إيران، مراقبة التحركات الحوثية، وخلق طوق استخباراتي يشمل القرن الأفريقي بالكامل، بما في ذلك الصومال، إريتريا، والسودان.
لا يمكن فصل المشروع الإسرائيلي في البحر الأحمر عن العقيدة الأمنية المعروفة باسم "مبدأ بيغن"، والتي تقضي بمنع أي تهديد جيوسياسي من التمركز في مناطق مجاورة أو قريبة من العمق الإسرائيلي. وقد توسع هذا المبدأ في العقود الأخيرة ليشمل ما يُعرف بـ "الأمن الاستباقي البحري"، حيث لا يكفي لإسرائيل تحصين حدودها البحرية شرق المتوسط، بل يتوجب عليها تأمين عمقها الجنوبي المتمثل في بوابة باب المندب. وهذا ما يفسّر استثمار إسرائيل في إنشاء أنظمة رادار متقدمة على جزيرة ميون قادرة على رصد الحركة البحرية والجوية في نطاق يصل إلى 450 كم، وتمتد تغطيتها إلى مضيق باب المندب والسواحل الغربية للسعودية، بالإضافة إلى صحراء جيبوتي الشمالية.
إن الدور الإسرائيلي لم يكن محصوراً على الدعم التقني والاستخباراتي، بل تعداه إلى ما يمكن وصفه بالتخطيط المشترك للمراحل اللاحقة من السيطرة. فوفقاً لتقارير استخباراتية غربية مسربة، فإن لجنة مشتركة تم تشكيلها عام 2020 بين الإمارات وإسرائيل تحت مظلة مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، وقد شملت مهامها إعادة تصميم الهيكل الأمني لمنطقة البحر الأحمر، عبر بناء قاعدة بيانات حيوية تغطي حركة السفن التجارية، الطيران المدني والعسكري، الأنشطة الاتصالية للموانئ المجاورة، وتتبع نشاطات القوات اليمنية المختلفة، بل وقياس مستوى الرضا الشعبي المحلي من خلال رصد منشورات شبكات التواصل وتحليلها. هذا الشكل من "الاستخبارات متعددة الأبعاد" هو من صميم الخبرة الإسرائيلية، وقد تم استنساخه في ميون بأسلوب متدرج.
التموضع الإسرائيلي في ميون يكتسب أهمية أخرى من كونه حلقة وصل بين مشروعين استراتيجيين: الأول هو المشروع الإماراتي الهادف إلى التحول إلى قوة بحرية إقليمية مستقلة عن السعودية، والثاني هو المشروع الإسرائيلي الساعي إلى إقامة ما يسمى بـ"قوس الرؤية الاستخباراتية" الممتد من قاعدة عصب في إريتريا، إلى سواحل السودان، مرورًا بميون، ثم عبر نقاط اتصال بحرية في البحر الأحمر الأعلى، بما في ذلك ميناء نويبع المصري ومدينة إيلات. هذه الشبكة من النقاط الحساسة تشكل ما يشبه القفص الذكي، الذي لا يتيح فقط المراقبة، بل أيضًا القدرة على الردع والتدخل السريع.
أما من الناحية الاستخباراتية الخالصة، فقد قامت إسرائيل بتجهيز جزيرة ميون بوحدة متقدمة من نظام ELINT المعروف باسم "إيليكس-2"، والذي يُستخدم في التقاط وتحليل الإشارات الكهرومغناطيسية وتحديد البصمات الإلكترونية للوحدات العسكرية المعادية. هذه الوحدة تُعد من أكثر الوحدات تطورًا في العالم، وهي قادرة على تحليل إشارات الرادار، الاتصالات اللاسلكية، وحتى تحديد موقع الغواصات التي تمر تحت سطح الماء عبر توقيعاتها المغناطيسية الدقيقة. وقد تم تثبيت هذه الأنظمة داخل أبراج مصممة على الطراز الإسرائيلي في الجزء الغربي من الجزيرة، وتحديدًا في أعلى نقطة جبلية تمنح تغطية بانورامية تصل إلى قناة السويس جنوبًا ومضيق هرمز شرقًا، عبر تداخل تقني مع أقمار صناعية إسرائيلية.
وفي الوقت ذاته، لم تغفل إسرائيل الجانب النفسي–الاجتماعي في عملياتها، حيث تم تخصيص وحدة داخل القاعدة تُعنى بإدارة ما يُعرف بـ "الوعي الأمني المحلي"، وهي وحدة مكونة من خبراء نفسيين واجتماعيين يعملون على تحليل توجهات سكان المناطق الساحلية المجاورة في المخا وذوباب، وحتى في بعض المناطق الإريترية، لمعرفة مدى تقبلهم أو رفضهم لوجود القاعدة. كما تستخدم هذه الوحدة تقنيات إعلامية دقيقة مثل إرسال إشارات إذاعية مشوشة، أو بث محتوى مُفبرك يعزز من صورة الإمارات كقوة استقرار في المنطقة، ويُضعف أي سردية مقاومة.
كل ذلك يجري ضمن بيئة دولية متسامحة إلى حد الصمت، بل ومشاركة في بعض الأحيان. فعدد من الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، أعربت في تقارير دبلوماسية عن "تفهمها للضرورات الأمنية" التي تفرض على إسرائيل والإمارات التواجد في هذه المنطقة، معتبرة أن الأمن البحري العالمي قد يتضرر في حال انسحاب هذه القوى. كما أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر أي قرار أو حتى بيان قلق تجاه ما يجري في ميون، رغم وضوح خروقات السيادة اليمنية، بل وأحيانًا السيادة الدولية على الممرات المائية.
ختامًا، لا يمكن فهم الدور الإسرائيلي في جزيرة ميون بمعزل عن تحولات أكبر تحدث في الإقليم، حيث تنتقل إسرائيل من دور الشريك غير المعلن إلى مركز توجيه للعمليات الاستخباراتية البحرية الإقليمية، بما يُعيد تعريف علاقتها بجيرانها العرب من علاقة صراع إلى علاقة توجيه وتحكّم. وإذا استمر هذا المنحى دون مقاومة يمنية أو ضغط أممي، فإن جزيرة ميون ستتحول إلى أول قاعدة بحرية إسرائيلية نشطة خارج المتوسط، يتم فيها دمج التفوق التكنولوجي مع التمويل الخليجي، في صيغة استعمارية جديدة تتجاوز الاحتلال المباشر إلى التمكين الهيكلي طويل الأمد، ما يمثل تحديًا وجوديًا ليس لليمن وحده، بل لمفهوم السيادة الوطنية في الإقليم بأسره.
الخاتمة
تُظهر هذه الدراسة بأقسامها المختلفة، من خلال التحليل الوثائقي والتحقيق الاستقصائي، أن ما يجري في جزيرتي ميون وزقر لا يمكن قراءته بمعزل عن المسارات الكبرى للصراع الإقليمي والدولي في البحر الأحمر، ولا عن طبيعة التحولات العميقة التي طرأت على مفهوم الاحتلال والسيطرة في القرن الحادي والعشرين. لقد أصبحنا أمام مشهد معقّد تتداخل فيه أدوات الاحتلال الناعم مع البنى العسكرية الخشنة، حيث تتقاطع المصالح الإماراتية مع الطموحات الإسرائيلية في فضاء جيوسياسي مفتوح، غير خاضع لأي شكل من أشكال الرقابة الدولية الفعالة أو المحاسبة القانونية الرادعة.
إن الوجود الإماراتي في ميون لا يحمل خصائص الوجود العابر المؤقت كما حاولت أبوظبي تصويره، بل يكشف – عند تفكيكه طبقةً تلو الأخرى – عن منظومة احتلال هجينة قائمة على تغليف المشروع العسكري بغلاف إنساني ومدني، في محاولة لشرعنة التحركات وتمويه النوايا الحقيقية. لقد بدا ذلك جليًا في المراحل الأولى من الانتشار الإماراتي، حين تم استخدام شعارات الهلال الأحمر والإغاثة لإدخال معدات بناء أولية ومنشآت مؤقتة، قبل أن يتحول الأمر إلى قاعدة عسكرية متكاملة تضم مطارًا بطول ثلاثة كيلومترات، وحظائر للطائرات المسيّرة، ومراكز استخبارات إلكترونية، وسجون سرية لا تخضع لأي إشراف قضائي. بل إن ما هو أخطر من ذلك هو التشبيك العملياتي والاستخباراتي بين القاعدة في ميون وقاعدة "عصب" في إريتريا، والربط المباشر مع الأجهزة الإسرائيلية عبر واجهات فنية وشركات وسيطة في أوروبا، مما يجعل من الجزيرة نقطة ارتكاز في مشروع تحالف أمني أوسع، لا يخدم اليمن بأي حال من الأحوال، بل يجعله ساحة صراع مفتوحة لخدمة أجندات لا تمت للسيادة بصلة.
كما أن هذه الدراسة تؤكد، بناءً على الوثائق التي تم تحليلها، أن الإمارات لم تعد تكتفي بدور الممول أو الداعم اللوجستي، بل انتقلت إلى موقع الفاعل الاستراتيجي المباشر، عبر إدارة البنية العسكرية على الأرض، وتوظيف خبراء أجانب، وتجنيد قوات يمنية محلية موالية، وتوقيع عقود استخباراتية وأمنية مع شركات عابرة للحدود. كل ذلك يتم دون أي تفويض قانوني من الحكومة اليمنية، بل أحيانًا رغمًا عنها، مستغلة حالة الانقسام السياسي، والفراغ المؤسساتي، وانشغال الأطراف المحلية بالصراعات الداخلية، ما جعل من الجزر اليمنية فراغًا سياديًا مفتوحًا للتلاعب والتموضع الخارجي.
إن الأهم في هذا السياق هو أن الاحتلال الجديد لا يرفع علمًا، ولا ينشر دبابات في الشوارع، بل يعتمد على البنى تحت السطحية، والإشراف غير المباشر، والتقنيات الذكية التي تمكّنه من السيطرة الفعلية دون الظهور العلني. وفي هذا النمط من السيطرة، تصبح الأدوات الإعلامية والتقارير المزيفة جزءًا من البنية العسكرية، حيث يتم ترويج روايات مضللة للرأي العام عن مشاريع تنموية مزعومة، بينما يتم في الواقع مصادرة الجغرافيا، وتقييد الحركة، ومنع دخول اليمنيين إلى أرضهم إلا بتصاريح عسكرية صادرة من قوى الاحتلال.
إن البنية العسكرية التي تم تحليلها في هذه الدراسة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن جزيرة ميون قد تم إخراجها من الإطار الوطني اليمني، وتحوّلت إلى كيان أمني منفصل، لا يخضع لسيادة الدولة، ولا يُدار ضمن أي إطار تحالفي معلن، بل تدار كأنها قاعدة سيادية إماراتية–إسرائيلية مستقلة، ترتبط بمحاور أمنية تمتد من الخليج إلى شرق أفريقيا، وترتبط بخطوط إمداد لوجستي جوي وبحري لا تمر بالضرورة عبر الأراضي اليمنية. وهذا بحد ذاته يُعد اختطافًا صريحًا للسيادة اليمنية، وإعادة تعريف لمفهوم الاحتلال عبر أدوات ناعمة ومركّبة.
وإذا أضفنا إلى هذا المشهد جزيرة زقر، التي يتم تحويلها تدريجيًا إلى نقطة مراقبة بحرية متقدمة، باستخدام تقنيات الرادار والتتبع البحري المتقدمة، فإن الصورة تكتمل: نحن أمام مشروع سيطرة متكامل يشمل المفصل الجغرافي الأهم في البحر الأحمر، يُدار بأدوات مدنية وعسكرية في آنٍ واحد، ويُشرف عليه خبراء من خارج الإقليم، وتموّله دولة خليجية ذات طموحات توسعية تتجاوز بكثير حدودها الطبيعية.
من الناحية الإنسانية، فإن ما يجري يُعد أيضًا انتهاكًا فجًا لحقوق السكان الأصليين في هذه الجزر، الذين تم تهجيرهم قسرًا، أو حرمانهم من العودة، أو منعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم التقليدية. ولم يتم إنشاء أي إطار قانوني أو تعويضي لهذه المجتمعات، بل جرى التعامل معهم كعقبة أمنية يجب التخلص منها. وتلك ممارسة تندرج ضمن أنماط التهجير القسري المصنّف كجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يتطلب تحقيقًا أمميًا مستقلاً وشفافًا.
إن ما تم استعراضه في هذه الدراسة يدفعنا إلى مجموعة من التوصيات الضرورية، التي تشكل خارطة طريق محتملة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة. أولى هذه التوصيات هي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تضم خبراء عسكريين وقانونيين، وتُكلّف بجمع الأدلة، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم ملف قانوني متكامل يمكن استخدامه في المحافل الدولية. فالدفاع عن السيادة لا يبدأ بالخطابات، بل بالعمل الممنهج على توثيق الحقائق وتحويلها إلى ملفات قانونية قابلة للتقاضي
ثانيًا، لا بد من إشراك المجتمع الدولي بشكل أكثر فعالية، عبر تقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، مع التركيز على البعد الإنساني للانتهاكات، وضرورة فتح هذه الجزر أمام لجان تحقيق دولية محايدة. إن صمت المجتمع الدولي لا يجب أن يتحوّل إلى ضوء أخضر للمزيد من الانتهاكات، بل يجب أن يُواجَه بحملات دبلوماسية وإعلامية مدروسة.
ثالثًا، يجب العمل على دعم الإعلام الوطني المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، وتمكينه تقنيًا وقانونيًا، ليكون قادرًا على كشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي. لقد أثبتت هذه الدراسة أن المعلومات الدقيقة يمكن الوصول إليها حتى في البيئات المغلقة، عبر تحليل الصور الجوية، وتقاطع الشهادات، وتتبّع العقود الموقعة، مما يعني أن معركة السيادة تبدأ من معركة الوعي والحقيقة.
رابعًا، من الضروري إعادة النظر في بنية العلاقات اليمنية–الإماراتية، وتقييم الدور الذي تلعبه أبوظبي في اليمن، ليس فقط من منظور الدعم العسكري أو الاقتصادي، بل من منظور السيادة الكاملة والشراكة الاستراتيجية. لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي الذي يتحوّل إلى تموضع دائم واحتلال مقنّع
خامسًا، يجب على القوى الوطنية والسياسية المختلفة تجاوز خلافاتها الآنية، والاتفاق على حد أدنى وطني يرفض التفريط في السيادة، ويعيد تعريف الأولويات الوطنية، بعيدًا عن الحسابات الفئوية أو المناطقية. إن ما يحدث في ميون وزقر ليس مسألة تتعلق بفصيل أو جهة معينة، بل هو اعتداء على الجغرافيا اليمنية بكاملها، ويتطلب ردًا وطنيًا موحدًا.
وأخيرًا، تدعو هذه الدراسة إلى ضرورة إعداد استراتيجية يمنية شاملة لإعادة دمج الجزر المحتلة ضمن الإطار السيادي، سواء عبر الضغط السياسي، أو المحافل الدولية، أو حملات التوعية، أو حتى إدراج هذه الجزر في المناهج التعليمية، ليبقى الوعي بالقضية حيًا في وجدان الأجيال القادمة. فالميادين تتغيّر، لكن المبادئ لا تتغيّر. والسيادة، كالماء، لا تُشرب إلا من منبعها الأصلي.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الاحتلال، بل في تطبيع الاحتلال، وجعله جزءًا من المشهد الاعتيادي الذي لا يُثير ردود أفعال. ولذلك، فإن هذه الدراسة لم تأت لتثير الغضب العابر، بل لتقدّم خارطة وعي ومقاومة طويلة الأمد، تُعيد تعريف علاقة اليمن بجغرافيته، وتُحرر مفهوم السيادة من القيود المفروضة عليه، لتعود هذه الجزر، في الوعي أولًا، وفي الواقع ثانيًا، إلى أهلها ووطنها.