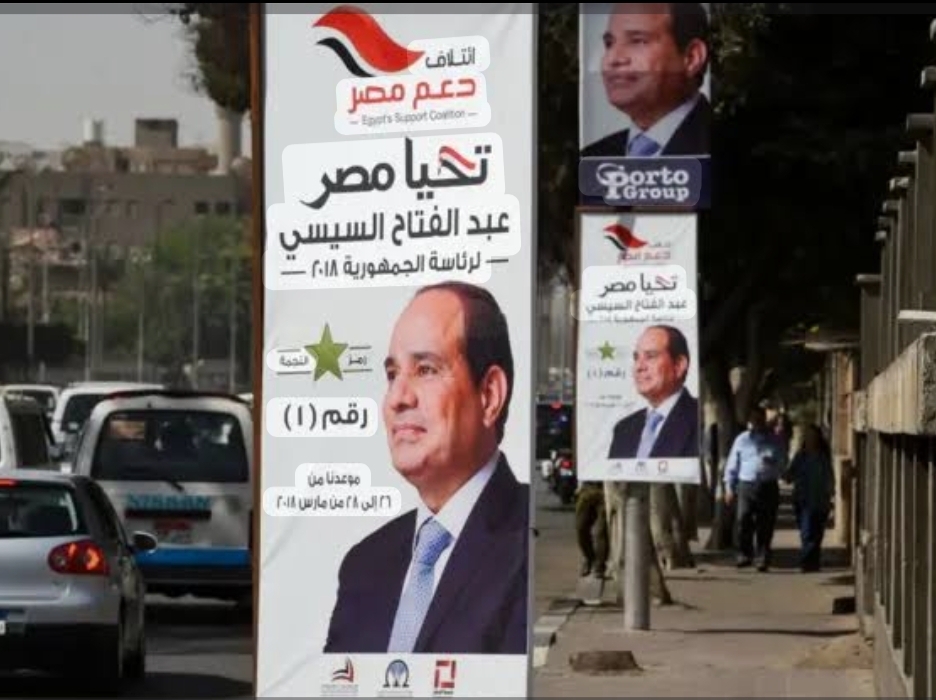�نا عدن | متابعات
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أزمة مصر الاقتصادية الحادة جعلت حتى “البقشيش” عبئًا متضخمًا، إذ لم يعد يقتصر على المطاعم والسائقين، بل يشمل موظفي الحكومة والمستشفيات، مشيرةً إلى أن التضخم وتراجع الأجور حوّلا الإكراميات من تعبير عن الامتنان إلى وسيلة للبقاء في اقتصاد يختلط فيه الشكر بالحاجة والمعيشة بالنجاة.
النادلون وعمال التوصيل يتلقون بقشيشًا، لكن كذلك موظفو الاستقبال، وموظفو الحكومة، والممرضات. ومع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حتى تكلفة “الشكر” باتت عبئًا إضافيًا على المصريين.
أزمة مصر الاقتصادية الحادة جعلت حتى “البقشيش” عبئًا متضخمًا، إذ لم يعد يقتصر على المطاعم والسائقين، بل يشمل موظفي الحكومة والمستشفيات.
عندما عاد “مصري”، بطل الفيلم الكلاسيكي “عسل مر” إلى القاهرة بعد عشرين عامًا قضاها في الولايات المتحدة، وجد نفسه مضطرًا للتأقلم من جديد مع تفاصيل الحياة اليومية في بلده.
غير أن الصدمة الكبرى كانت عندما ذهب لاستخراج جواز سفر جديد. طلب الموظف المسؤول “الشاي” بمئة ملعقة سكر -تعبير رمزي عن طلب رشوة- وعندما أبدى “مصري” دهشته، سأله الموظف ساخرًا: “أتريد أن أساعدك؟ أم تفضل أن تذهب إلى نهاية الطابور بضمير مرتاح؟”.
في مصر، أصبح دفع المال لتسريع المعاملات أو تجاوز الطوابير أمرًا مألوفًا، إلى درجة أنه يُحتسب أحيانًا ضمن النفقات التشغيلية في بعض الشركات. وكما هو الحال في دول كثيرة، يحصل النادلون وسائقو التوصيل وعمال مواقف السيارات على بقشيش، لكن في مصر، يشمل الأمر أيضًا موظفي الاستقبال في العيادات، وموظفي الحكومة، وحتى الممرضات اللواتي قد يطلب بعضهن “إكرامية” مقابل جلب الماء أو مساعدة المريض في تبديل ملابسه.
البقشيش لم يسلم من التضخم
بعد مرور خمسة عشر عامًا على عرض فيلم “عسل مر”، ما يلفت انتباه المشاهدين اليوم ليس الفساد الإداري، بل قيمة “الشاي” نفسها.
ففي عام 2010، كانت مئة جنيه مصري تعادل نحو 18 دولارًا أمريكيًا. أما اليوم، وبعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية وانهيار الجنيه، فلم تعد تساوي سوى نحو دولارين فقط.
ومع ذلك، حتى هذا المبلغ أصبح مرهقًا للكثير من المصريين. فقد ظلّ التضخم في خانة العشرات منذ بداية الأزمة في عام 2022، وبلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 11.7% في سبتمبر الماضي بعد حصول مصر على حزم دعم مالية من صندوق النقد الدولي، والإمارات، والاتحاد الأوروبي.
لكن وتيرة الإصلاح بطيئة، والشارع المصري لا يزال مثقلًا بسنوات من التقشف وارتفاع تكاليف المعيشة.
تقول مارينا قلادس (29 عامًا)، مديرة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القاهرة: “لقد أصاب التضخم كل شيء، حتى البقشيش. في السابق، كان الناس يدفعون 10 أو 20 جنيهًا، وكان ذلك كافيًا. أما الآن، فإذا دفعت 10 جنيهات فلن يكون لها أي قيمة تُذكر”.
بالنسبة للبعض، أصبح البقشيش شكلًا من أشكال الصدقة أو الواجب الديني، في محاولة لتقليص الفجوة المتسعة بين من يملكون ومن لا يملكون.
وتضيف أن والدها، عندما دخل المستشفى في مارس الماضي بسبب الفشل الكلوي، لم تتلقَّ الممرضات طلباته إلا بعد أن بدأت تدفع لهن بقشيشًا، نحو دولار واحد يوميًا لكل ممرضة”. الرواتب ضعيفة للغاية، والناس مضطرة إلى الاعتماد على البقشيش لتغطية احتياجاتها.”
بين الامتنان والرشوة
يُعدّ البقشيش عادةً مصرية متجذّرة في الثقافة الاجتماعية، غير أن الجدل لا يزال قائمًا حول دلالته: هل هو تعبير عن الامتنان أم شكلٌ من أشكال الرشوة المقنّعة؟
تحكي مارينا أنها كانت قبل عامين في طابور طويل لتجديد رخصة قيادتها وكانت على عجلةٍ من أمرها. وبينما كانت تنتظر، لاحظت أشخاصًا يدفعون “إكرامية” لموظف ليسمح لهم بتجاوز اختبار القيادة. تقول إنها رفضت ذلك مبدئيًا، لكنها في النهاية دفعت للموظف ألف جنيه (33 دولارًا حينها) بعدما سمح لها بتجاوز الطابور.
وتضيف: “لو حدث ذلك اليوم، لكنت مضطرة لدفع 1800 جنيه (نحو 38 دولارًا) لنفس الخدمة.”
البقشيش بين الواجب الديني والحاجة إلى البقاء
بالنسبة للبعض، أصبح البقشيش شكلًا من أشكال الصدقة أو الواجب الديني، في محاولة لتقليص الفجوة المتسعة بين من يملكون ومن لا يملكون.
وتشير آخر إحصاءات عام 2019 إلى أن نحو 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة يُرجّح أنها ارتفعت بعد جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الأخير، خاصة بعد خفض الحكومة دعم الخبز والوقود والكهرباء.
تقول مي محمد صادق، معلمة لغة إنكليزية في القاهرة: “كنت أقدم خمسة جنيهات قبل الأزمة، أما الآن فأعطي عشرة أو خمسة عشر جنيهًا للبائع أو العامل. لم يعد الأمر مجرد شكر، بل شعور بأنك تساعد من يحتاج.”
لكنها تعترف بأنها تنزعج من ظاهرة “الركنجي” الذي يظهر فجأة في الشارع ليطلب بقشيشًا رغم أنه لم يقدّم أي خدمة حقيقية: “إنه لم يفعل شيئًا، ومع ذلك يطلب مالًا.”
وترى أن الإكراميات التي تمنح أصحابها ميزة على الآخرين -كقطع الطوابير أو تجاوز الإجراءات- تخلّ بمبدأ العدالة وتُكرّس ثقافة التفاوت الاجتماعي.
هذه المبالغ الصغيرة هي ما يُبقي عجلة الحياة المصرية تدور. فالبقشيش بالنسبة لكثيرين أصبح “زيت الماكينة” الذي يمنع توقفها في بيروقراطيةٍ مثقلة بالإجراءات.
البقشيش كزيتٍ للحياة اليومية
مع ذلك، يرى آخرون أن هذه المبالغ الصغيرة هي ما يُبقي عجلة الحياة المصرية تدور. فالبقشيش بالنسبة لكثيرين أصبح “زيت الماكينة” الذي يمنع توقفها في بيروقراطيةٍ مثقلة بالإجراءات.
يقول عمرو أحمد (55 عامًا)، فني كمبيوتر من القاهرة: “كنت في عيادة مزدحمة للغاية، وكنت أعلم أنني سأنتظر طويلًا. فأعطيت موظف الاستقبال خمسين جنيهًا (نحو دولار واحد) ليدخلني قبل الآخرين. في الماضي، كنت أقدم خمسة جنيهات فقط.”
ويضيف بابتسامة متعبة: “أحيانًا تشعر بالحرج إذا دفعت مبلغًا صغيرًا، لأنك تعرف مدى ضآلة قيمته. عندما تعطي بقشيشًا، تريد أن تقدّم شيئًا ذا معنى.”
في بلدٍ تتآكل فيه الأجور وتنهار فيه العملة، لم ينجُ حتى “البقشيش” من آثار التضخم. لقد أصبح مرآةً للأزمة نفسها: بين من يدفع طلبًا للكرامة، ومن يتلقّى طلبًا للبقاء.
(القدس العربي)